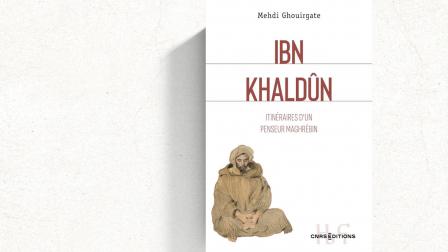ربما تكون إحدى إنجازات ثورة 25 يناير، أنها طرحت على المجتمع المصري قضايا جديدة للنقاش، وأعادت فتح قضايا قديمة لتحليلها في سياق مختلف بعد عمليات تجريف الوعي الثقافي والسياسي التي قامت بها الأنظمة في مصر خلال العقود الأخيرة، ومنها قضية "اليسار المصري".
وبحكم إقامته في القاهرة منذ عدة أعوام، استطاع الباحث والأكاديمي الإيطالي جينارو جيرفازيو، المختص في تاريخ وسياسة "الشرق الأوسط"، أن يقوم بالعديد من اللقاءات مع عدد كبير من رموز اليسار المصري، الرسمي والراديكالي، على حد سواء.
أثمرت هذه اللقاءات عن أطروحته لنيل الدكتوراه من جامعة نابولي، التي أصبحت بعد ذلك كتاباً بعنوان "الحركة الماركسية في مصر 1967 – 1981" (نُشر في "المركز القومي للترجمة" في القاهرة في 2010، وسيصدر قريباً في طبعة جديدة).
وقف جيرفازيو في كتابه عند أهم الأحداث التي أثّرت في تطور أفكار وممارسات اليسار في مرحلة ما بين النكسة واغتيال السادات، محاولاً تحليل العلاقة المعقدة بين قوى اليسار والسلطة. كما قام بالعديد من الأبحاث حول الحركة الماركسية والمعارضة العلمانية في مصر، ودور المثقف وسياسات الإعلام، للتفتيش عن الأسباب التي أدّت إلى التراجع شبه الكامل لدور اليسار في البلاد.
إذ أنه، رغم تفهمه حالة القمع التي تعرض لها اليسار، يرفض حصر أسباب خسوف البديل الماركسي في قمع النظام بمساعدة الجماعات الإسلامية نهاية السبعينيات. ففي حديثه إلى "العربي الجديد" يقول: "برأيي، إن أحد أهم أسباب تراجع اليسار هو تركيزه على المسألة القومية على حساب ما يحدث داخل البلاد من تحولات اجتماعية. مثقفو اليسار في هذه المرحلة ظلوا ينظرون إلى الواقع بعيون الستينيات الناصرية الحالمة، أعني المعنى الإيجابي للكلمة؛ أي الحلم التحرري. وهو ما يفسر سبب تقديم المسألة القومية والنظر إلى علاقات مصر الخارجية أكثر من الداخل".
ويضيف: "مع تفهمي لحساسية اللحظة التي كانت فيها سيناء محتلة، إلا أنه لا يبرر برأيي عدم وضع القضية الاجتماعية أيضاً على قائمة الأولويات، وبالتالي فأنا أتفق مع رأي بعض مفكري اليسار، القائل بأن اليسار أضاع فرصة ذهبية أثناء انتفاضة يناير 1977 بل أرى أنه أضاع الفرصة قبل الانتفاضة بعامين، عندما كان المجتمع المصري بأكمله محتجاً على التحولات الاقتصادية تحت شعارات اجتماعية واضحة. باختصار، كان ينبغي النظر إلى ما يحدث في المصانع بالتوازي مع النظر إلى الصراع العربي الإسرائيلي".
وعن علاقة المثقف بالسلطة في البلاد العربية يقول: "الحقيقة أن هذه العلاقة شائكة في العالم بأكمله، وخصوصاً في العالم الثالث. مثلاً بالرغم من أن الحياة الثقافية والفكرية في مصر كانت قوية نوعاً ما في ما يسمى بالمرحلة الليبرالية (1922 - 1952)، وخصوصاً في الأربعينيات، إلا أن كثيراً من مثقفي هذه المرحلة كانوا نخبويين".
"فطه حسين، على سبيل المثال، ظلّ هائماً في حلم الخديوي إسماعيل الذي يرى مصر امتداداً لأوروبا، وبالتالي لم يأت الحراك إلا من المؤسسة العسكرية في يوليو. ومع صعود نظام يوليو ظنّ المثقفون أنهم سيأخذون دوراً حقيقياً، لكنه لم يحدث، خصوصاً بعدما وجدوا أنفسهم مجرّد "موظفين بارزين" لدى السلطة".
كثيراً ما يُذكر أن تأثير اليسار ثقافياً فاق تأثيره سياسياً، فيعقب جيرفازيو: "بالفعل تفوق الإبداع الأدبي على التحليلات السياسة، وقد يفسر ذلك بأن الحقل الثقافي كان مفتوحاً أكثر من السياسي في تلك المرحلة، فلجأ اليسار إلى التعبير عن رأيه من خلال الأدب، وخصوصاً أن أغلب أدباء ذلك الوقت كانوا يتبنون أفكاراً يسارية، مثل يحيى الطاهر عبد الله وآخرين. وهذا لا ينفي وجود تحليلات سياسية جيدة، مثل التي صدرت عن "حزب العمال الشيوعي المصري"، لكنها ظلت غير قادرة على التفاعل مع الجماهير، وهو ما سيعيدنا إلى التساؤل حول وجود اليسار عملياً في ظل الاحتجاجات شبه التلقائية يومياً".
يميّز جيرفازيو كثيراً في أبحاثه ما بين "اليسار الرسمي" و"اليسار الراديكالي"، على مستوى تاريخ كل منهما وأيديولوجيته وعلاقته بالسلطة في ظل المحاولات المستمرة من جانب الأنظمة لاحتواء اليسار:
"الإشكالية هنا جاءت مع غياب الحياة الحزبية في منتصف الستينيات، فتباينت الآراء حول إمكانية المعارضة من داخل النظام، ومع مرور الوقت أصبح اليسار المعارض من الداخل "اليسار الرسمي" جزءاً من النظام، تجلى ذلك بوضوح في مجموعة لطفي الخولي في مجلة "الطليعة"، في المقابل كانت هناك مجموعات تقدم رؤى أكثر راديكالية، وخصوصاً عندما لاحظت أن احتواء اليسار الرسمي لم يكن إلا لإعطاء النظام صبغة اشتراكية فقط".
ويضيف: "حاولت في كتابي أن أنصف التجربة الراديكالية وأن أتتبع مواقفها، ولكن للأسف هناك صعوبة في الحصول على وثائق هذه التجربة، لأن أكثرها كانت سرية. ورغم الاعتراف بعدم تأثيرها الكافي على المجتمع، إلا أنه لا يمكن إنكار الدور الذي قامت به على مستوى النقد الذاتي والمراجعات، التي وصلت إلى حد القطيعة مع تراث الماركسية المصرية، مما أحدث جدلاً ماركسياً واسعاً في السبعينيات، على عكس مجموعات اليسار الرسمي التي عاشت مع الأنظمة أكثر من "شهر عسل" وصولاً إلى الذوبان التام داخل نظام مبارك".
ربما تكون مشاركة عدد لا بأس به من الماركسيين المصريين في تجربة "الحركة من أجل التغيير"، التي تأسست في 2004 وعرفت باسم "كفاية" هي ما جعلت جيرفازيو يرى قبل ثورة يناير أن اليسار رغم تفرّقه يمكنه أن يكون البديل الوحيد العلماني في مصر. في هذا السياق يقول:
"كنت أعني البديل على المستوى الفكري وليس الشعبي، وما زلت أؤمن بذلك، وإذا تابعنا البرامج التي تقدّم بها المرشحون للرئاسة أثناء الانتخابات الحرة الوحيدة في 2012 سنلاحظ أن برنامج خالد علي هو البرنامج اليساري المتكامل الوحيد، لكن للأسف بعد الثورة عادت انشقاقات اليسار من جديد، بسبب محاولات جيل اليسار القديم السيطرة على المشهد".
وحول الصراع العلماني الإسلامي المثار في مصر الآن على المستويين السياسي والثقافي، يقول جيرفازيو: "لا أستطيع إنكار وجود هذا النوع من الصراع، لكنني أرى أنه صراع يُراد له أن يبرز على حساب الصراع الحقيقي بين المجتمع المدني والمجتمع العسكري. لذلك أستغرب موقف بعض المثقفين الذين يرون أن المؤسسة العسكرية علمانية، لأنها برأيي محافظة إلى درجة لا تقل عن الإسلاميين. والعلمانية ليست قيمة مطلقة؛ العلمانية طريقة تفكير، قائمة في الأساس على حرية الفكر والتعبير، على جميع المستويات، بما في ذلك حرية العبادة، وهو ما يسمح لنا أن نرى الصراع الحالي في مصر خارج جدلية الدين والعلمانية".