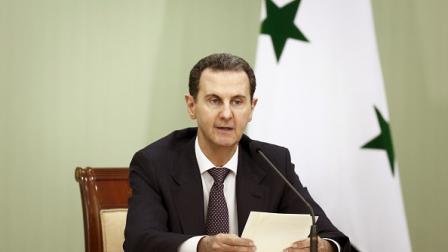الشاهد أثناء التسلم والتسليم مع الصيد (فرانس برس)
أسباب عدة أطاحت برئيس الحكومة التونسية السابق الحبيب الصيد، وجاءت بيوسف الشاهد مكانه. بعض الأسباب سياسي بامتياز، لارتباطه بمؤسسة الرئاسة والأحزاب، والبعض الآخر متعلق بمستقبل الحياة السياسية في تونس ورهانات الحكم. كما أن هناك أسباباً أخرى تتعلق بشبه الإجماع الحاصل حول فشل الصيد في التواصل مع التونسيين، بحكم أنه لم يكن خطيباً جيداً، ولم ينجح أيضاً في وضع خطة "اتصالية" قد تحدّ من حجم هذا الفشل، بالإضافة إلى انتمائه لمدرسة تونسية قديمة، انتمت إليها معظم القيادات الإدارية من جيله، وتعتمد العمل على الملفات بدلاً من تحسين الصورة الإعلامية وصيانة الظهور العلني، إذ كان الصيد شديد المراس في هذه الناحية، ورفض الإنصات إلى مستشاريه أكثر من مرة بهذا الخصوص.
في هذا السياق، عمل رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي على اختيار رئيس حكومته الجديد، وهو الذي أسرّ أكثر من مرة، ولمّح علناً أيضاً، إلى أنه لم يكن راضيا عن أداء الصيد في الجانب الإعلامي، على الرغم من انتمائه لمدرسة الحبيب بورقيبة التي تؤمن بالخطابة والاتصال المباشر والإقناع.
بالتالي لم يكن اختيار السبسي للشاهد اعتباطياً، وظهر ذلك، وفقاً لمراقبين، في نجاح الشاهد في اختباره الأول أمام البرلمان، أواخر الشهر الماضي، حين تمكن من إقناع النواب بخطاب فيه الكثير من المصارحة، واعتماد أسلوب المواجهة المباشرة بحقائق حول الوضع التونسي.
غير أن الاختبارات المتتالية، كشفت أن الشاهد ليس بأفضل بكثير من سَلَفَه، وفوجئ أولاً في منطقة القصرين، بعملية استهدفت دورية أمنية، تلاها حادث سير مؤلم في خمودة، في أوقاتٍ متزامنة بين أواخر الشهر الماضي ومطلع الشهر الحالي. وأظهر تعاطي الشاهد في هذين الملفين، تشابهاً مع الصيد، خصوصاً أنه زار القصرين فجراً، من دون أن يلتقي أهل المدينة، ولم يزر خمودة.
ولم يكد الأمر ينتهي بالنسبة إليه في القصرين وخمودة، حتى قامت الاحتجاجات في فرنانة، الواقعة في الشمال الغربي لتونس، ولا تبعد كثيراً عن الحدود الجزائرية التونسية. وبعد أن دامت الاحتجاجات لأكثر من عشرة أيام، خفتت، قبل أن تتأجج بفعل وفاة شاب أحرق نفسه. وقام المحتجون بقطع الطريق الرئيسية، علماً بأنهم كانوا يطالبون منذ اليوم الأول بالتفاوض مع وفد وزاري، لا مع المسؤولين الجهويّين. وعلى الرغم من ذلك لم يتحول أي وزير إلى الجهة المحتجة، ولم يكلّف رئيس الحكومة نفسه حتى عناء الاستماع للشباب المحتج.
اقــرأ أيضاً
ومع تتالي الأيام واستمرار الاحتجاجات وتجاهل الحكومة، طُرح السؤال حول إذا ما كان هذا التجاهل سياسة جديدة في التعامل مع بؤر التوتر التونسية، وعدم الرضوخ للاحتجاجات، وذلك بهدف تحويل العدوى إلى جهات أخرى، وإقناع الجميع بأن سنوات الاحتجاج قد ولّت، ولن تقود إلى تحقيق أي نتيجة.
غير أن هذا الأمر، لا يمكن أيضاً أن يكون شكلاً من أشكال تعاطي الحكومة مع شعبها، لأن أحداً لا يضمن ألا تتصاعد الاحتجاجات وأن تقود إلى ما لا يحمد عقباه، خصوصاً، أن المحتجين في فرنانة رفضوا تسييس مطالبهم، ومنعوا كل شبهة حزبية عن اعتصاماتهم.
غير أن الشاهد آثر ترويج صورة أخرى عن قربه من الناس، فزار مطعما شعبيا لتناول الطعام، غير أن هذا المطعم لم يكن في المناطق المحتجة، بل كان على بعد أمتار من قصر الحكومة بالقصبة. كما تناول الطعام مع بعض موظفيه. مع العلم أنه كان يمكن للصورة أن تحمل دلالات هامة لو قام رئيس الحكومة بهذه الخطوة في خمودة أو فرنانة أو القصرين.
وعلى الرغم من أن الحكم على الشاهد قد يكون ظالماً وغير موضوعي، بعد أيام قليلة فقط من توليه المهمة، إلا أن الاختبارات حتى الآن، كشفت أنه ليس أفضل من خلفه الحبيب الصيد في التعاطي مع بؤر الاحتجاج التونسية، وحجم ملفاتها المثقلة بالبطالة والفقر وغياب الحد الأدنى من العيش الكريم. كما لم يقدم حتى الآن فكرة واضحة عن برنامج عمل حكومته في الفترة المقبلة، لمعرفة ما إذا كانت ستكون مغايرة للحكومات السابقة، وإذا ما كان اختيار السبسي في محله.
اقــرأ أيضاً
في هذا السياق، عمل رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي على اختيار رئيس حكومته الجديد، وهو الذي أسرّ أكثر من مرة، ولمّح علناً أيضاً، إلى أنه لم يكن راضيا عن أداء الصيد في الجانب الإعلامي، على الرغم من انتمائه لمدرسة الحبيب بورقيبة التي تؤمن بالخطابة والاتصال المباشر والإقناع.
غير أن الاختبارات المتتالية، كشفت أن الشاهد ليس بأفضل بكثير من سَلَفَه، وفوجئ أولاً في منطقة القصرين، بعملية استهدفت دورية أمنية، تلاها حادث سير مؤلم في خمودة، في أوقاتٍ متزامنة بين أواخر الشهر الماضي ومطلع الشهر الحالي. وأظهر تعاطي الشاهد في هذين الملفين، تشابهاً مع الصيد، خصوصاً أنه زار القصرين فجراً، من دون أن يلتقي أهل المدينة، ولم يزر خمودة.
ولم يكد الأمر ينتهي بالنسبة إليه في القصرين وخمودة، حتى قامت الاحتجاجات في فرنانة، الواقعة في الشمال الغربي لتونس، ولا تبعد كثيراً عن الحدود الجزائرية التونسية. وبعد أن دامت الاحتجاجات لأكثر من عشرة أيام، خفتت، قبل أن تتأجج بفعل وفاة شاب أحرق نفسه. وقام المحتجون بقطع الطريق الرئيسية، علماً بأنهم كانوا يطالبون منذ اليوم الأول بالتفاوض مع وفد وزاري، لا مع المسؤولين الجهويّين. وعلى الرغم من ذلك لم يتحول أي وزير إلى الجهة المحتجة، ولم يكلّف رئيس الحكومة نفسه حتى عناء الاستماع للشباب المحتج.
ومع تتالي الأيام واستمرار الاحتجاجات وتجاهل الحكومة، طُرح السؤال حول إذا ما كان هذا التجاهل سياسة جديدة في التعامل مع بؤر التوتر التونسية، وعدم الرضوخ للاحتجاجات، وذلك بهدف تحويل العدوى إلى جهات أخرى، وإقناع الجميع بأن سنوات الاحتجاج قد ولّت، ولن تقود إلى تحقيق أي نتيجة.
غير أن هذا الأمر، لا يمكن أيضاً أن يكون شكلاً من أشكال تعاطي الحكومة مع شعبها، لأن أحداً لا يضمن ألا تتصاعد الاحتجاجات وأن تقود إلى ما لا يحمد عقباه، خصوصاً، أن المحتجين في فرنانة رفضوا تسييس مطالبهم، ومنعوا كل شبهة حزبية عن اعتصاماتهم.
غير أن الشاهد آثر ترويج صورة أخرى عن قربه من الناس، فزار مطعما شعبيا لتناول الطعام، غير أن هذا المطعم لم يكن في المناطق المحتجة، بل كان على بعد أمتار من قصر الحكومة بالقصبة. كما تناول الطعام مع بعض موظفيه. مع العلم أنه كان يمكن للصورة أن تحمل دلالات هامة لو قام رئيس الحكومة بهذه الخطوة في خمودة أو فرنانة أو القصرين.
وعلى الرغم من أن الحكم على الشاهد قد يكون ظالماً وغير موضوعي، بعد أيام قليلة فقط من توليه المهمة، إلا أن الاختبارات حتى الآن، كشفت أنه ليس أفضل من خلفه الحبيب الصيد في التعاطي مع بؤر الاحتجاج التونسية، وحجم ملفاتها المثقلة بالبطالة والفقر وغياب الحد الأدنى من العيش الكريم. كما لم يقدم حتى الآن فكرة واضحة عن برنامج عمل حكومته في الفترة المقبلة، لمعرفة ما إذا كانت ستكون مغايرة للحكومات السابقة، وإذا ما كان اختيار السبسي في محله.