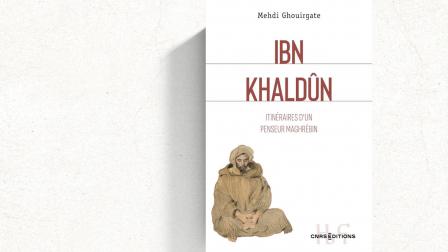يتناول عمل "38 يومًا من إعادةِ التجميع" العلاقةَ بين واقعين اثنين: الأول هو الاحتلال الإسرائيلي والثاني هو حقّ عودة الشعب الفلسطيني. هذه هي القصة التي تتشكّل لنا في ظاهر العمل. إلا أنّ نظرةً دقيقة أخرى إلى الأجزاء التي يتألفُ منها، ستكشف لنا طبقاتٍ رقيقةً متعددةً بمعانٍ وظلالٍ شتّى. وتكمن التجربةُ الأساسيةُ في هذا العملِ في تحويلِ صورةٍ رقميّة يمكن استنساخها بلا حدّ إلى صورةٍ أصليّةٍ لا تتكرّر وتتحول إلى عملٍ فنيٍّ فريد. حين خرجتُ من غرفة التحميض ورأيتُ الصورة، خُيّل إليّ أنّني قد حللت شيفرة بصريّة، ثم ما لبثتُ أن اكتشفْتُ أنّني أمام معضلةٍ بصريّة حقيقيّة.
حين عرضت عمل "38 يومًا من إعادة التجميع" على الناقدة فينيشا بورتر في المتحف البريطاني، أخبرتني أنّ عليّ أن أحرِصَ على الأجزاء كي لا تتهشّمَ نظرًا إلى هشاشتها، بل قالت بالحرف الواحد "إن أجزاءَها تكاد تسقطُ بمجرد النظر إليها". وخرجتُ بعدها من المتحفِ وتوجّهت إلى محطة الأنفاق وحين استخدمت بطاقة المواصلات للخروج من المحطّة، سقط من بين يدي أحد الصناديق، فتحطّمت واحدةٌ من أكثرِ القطعِ التي تعلّقتُ بها، وهي هذه التي ترونها في الصورة. هذه القطعةُ لم تعد موجودةً، ولم يبقَ سوى الصور الرقميّة التي تدلّ على وجودها وتؤكّد أنّها كانت حقيقةً قائمةً من قبل. هذا كان تحدياً بالنسبةِ إلي، لأنّ العملَ الفنيَّ كان يتحوّلُ بمجردَ إتمامِهِ إلى جزءٍ من تاريخي الفنيِّ الشخصيِّ. في النهاية، فازت الصورةُ، لأن الشيء الوحيد الذي يثبت وجود العمل الفني صورَتُهُ. وهكذا صارَ عملُ "38 يومًا من إعادة التجميع" رحلةً لاستكشاف أصل الصورة.
كما أنَّ هذا العمل يكشفُ عن عددٍ من الطروسِ، والطِّرسُ هو مخطوطةٌ مُحِيَت ليُكتَبَ عليها من جديد، طبقةً على طبقةٍ من المحتوى والمعنى، وهكذا فإن عمل "38 يومًا من إعادة التجميع" لا يستكشف تاريخ المنزل في مدينة القدسِ فحسب، وإنّما يستكشفُ تاريخَ الصورةِ نفسِها.
هنالك فكرةٌ راسخةٌ عن التصويرِ مَفادُها أنّ بالإمكان فَهمَ جميعِ الصورِ أو تفسيرها بطرقٍ متعددةٍ ومختلفةٍ وأنّ بعض الحقائق فيها تبقى محجوبةً. إلا أنّ فهمي لهذا الأمرِ قد تطورَ عبر السنين من خلال أعمالي نفسِها وعلى شكلِ بحثٍ بصريٍّ. ففي مشروعٍ أطلقت عليه اسم "بحث" عام 1997، تم فيه استخدامُ فيلمٍ بتقنيةِ الأشعةِ تحت الحمراء لتصوير الضوء الذي لا تلحظه العين البشرية. وكما يظهر في الصورةِ، فإن السماءَ الزرقاءَ قد صارت سوداءَ قاتمةً وتحوّلَ العشبُ من اللونِ الأخضرِ إلى الأبيض، كما نرى أنّ الشجرةَ تلمعُ. والفكرةُ هنا هو أنَّ عدمَ رؤيتِنا للشيء لا يعني بالضرورةِ أنّه غيرُ موجود.
أما في مجموعةِ "الأيامِ الأخيرةِ" الي أنتجتُها عامِ 2003، فقمتُ بمراجعةِ بعضِ الصورِ التي التقطتُها أصلًا لعملٍ سابقٍ، ولاسيّما في مشروعِ "هويّة" الذي أنتجتهُ في 2002، وتمكّنتُ في هذه العمليةِ من النظرِ عبرَ هذهِ الصورِ واكتشفتُ أنّها تخفي في جنباتِها حقائقَ أخرى.
هنالكَ إذن حقائقُ مدفونةٌ في الصورِ.
أما في مشروعِ "في المنفى" عام 2008، فالتقطتُ صوراً من زوايا مختلفةٍ وقمتُ بجمعِها في كولاجاتٍ سعيًا لخلقِ أشكالٍ جديدة. وأثناءَ قيامي بالعمل تساءلتُ إن كنتُ حقًّا أخلقُ شيئًا جديدًا أو أنني أكشفُ عن شيءٍ كان موجودًا أصلًا وينتظرُ أن يُكتشف.
رأيت أنّ الكولاجَ يسمح بعدد لا متناهٍ من التجاربِ والاكتشافاتِ، فأنا مأخوذٌ بالصورِ المقطوعةِ، لأنّها قادرةٌ على كشفِ حقائقَ مخفيّةٍ أو "صورٍ ذهنيةٍ" بالاعتمادِ على المخيلة. وهكذا صرتُ أسعى في أعمالي إلى أن أكشفَ عن صورةٍ لم يكن في الإمكانِ رؤيتها من قبل.
لقد بدأتُ الآنَ بمراجعةِ أعمالي وإعادةِ النظر إليها محاولًا التخلصَ من جميعِ النُّصوصِ والأفكارِ والمفاهيمِ التي ارتبطتُّ بها. وقد بلغتُ مرحلةً أتعلّم فيها كيفيةَ الوصولِ إلى قراءاتٍ جديدةٍ تتجاوزُ المقاصدَ الأصليةَ للأعمالِ، وهي مقاصدُ مرتبطةٌ بسياقاتِ العملِ، أكثر من ارتباطِها بالصورِ نفسِها. ولهذا بدأتُ بالنظرِ إلى الأعمالِ باعتبارِها طروسًا بصريّةً، المخفيّ فيها أكثر من الظاهرِ منها.
***
فلنعُد الآن إلى مجموعةِ "38 يومًا من إعادة التجميع"، حيثُ تشبه الطبقاتُ المتعدّدةُ هنا طبقاتِ الكولاج. إن الصورَ باللونين الأبيضِ والأسودِ للبيتِ الذي سكنتُهُ قد طُبعتْ بمحلولٍ فوتوغرافي أبيضٍ وأسودٍ على أجزاء من قشورِ طلاءٍ ملوَّنةٍ جمعتُها من جدرانِ بيتي وغيرها في البلدة القديمة في القدسِ. ولو نظرَ عالمٌ أثريٌّ إلى هذهِ القطعِ لظنَّ ربّما أنّها قطعٌ أثريّةٌ هامّةٌ تمَ اكتشافُها، ولكنّهُ حينَ ينظرُ إليها بدقّةٍ سيجد أنّها شظايا تشكّلت بوهمٍ ما.
إن حلَّ الرموزِ لهذهِ القطعِ يتطلّبُ منهجيةً جديدةً في الأركيورلوجيا التقليدية، وذلكَ أنَّ "القطعةَ الفنيّةَ" قد جاءت نتيجةَ عمليةٍ فوتوغرافيّة، وإنّ فكَّ رموزِها يحتاجُ منّا إلى فهمِ الصور. ولكنَّ فَهمنا للصورِ وأصولِها وتشكّيلِها ومدركاتِها لا يزالُ في مراحلِهِ الأولى.
من السابقُ على الآخرِ، العالمُ أم الصورة؟ العالم أم صورتُه؟ إنَّ البحثَ في هذا السؤالِ يقودُنا إلى تحديدِ أصلِ الصورةِ أو مصدرِها. وإن كان العالمُ صورةً منذُ الأزلِ على حدِ وصفِ الفلاسفةِ والمنظرين، فإنّ بحثَنا يصلُ إلى نقطةِ الما لا نهاية، غير أنّ هذا لا يمنعُ من أن نحلَّ بعضَ الألغازِ البصريّةِ في خضَمِّ هذا السعيِ الذي لا حدَّ لهُ. لعلَّ الصورَ التي وجدتْ في الكهوفِ قد كانت المحاولاتِ الأولى للإنسانِ ليصوّرَ وليحلَّ رموزَ الصورِ التي تخيّلَها عن نفسِهِ. إنَّ دراسةَ هذهِ الصورِ هي دراسةٌ في علم الآثار البصري. وربّما كانت تلكَ هيَ لحظةُ اكتشافِنا لجينوماتِنا البصرية، بحمض نووي متشكل من الضوء أو المنعكس عنه.
فقد استطعنا من خلالِ الرسمِ على الحجارة (في الكهفِ) من تثبيتِ وهم الرؤيةِ التي افترضناها بخيالنا. ومع تتالي العصور تمكنّا من وضع هذا الضوء على الورق وعلى ألواح معدنيّة ونشأ فنُّ التصويرِ. لقد شكّلت الصورُ الثابتة صدمة للعالم حينها، إذ كانت الأقرب إلى الوهم الذي تمكنت أعيننا من رؤيته، إلا أنّها لا علاقة لها بالحقيقة مطلقًا، وهكذا شكّلت الصور عالمًا بذاتها.
ولأن الصّور شكّلت وعيًا بالعالم خاصًا بها، فإنني أتساءل إن كان قد حان الوقت لنتوقّف عن التركيز على الرابط بين الصور و"العالم الحقيقيّ". لعلّنا نحتاج بدلًا من ذلك إلى استكشاف العناصر البصرية للعالم من خلال النظر في الصورة نفسها، كما لو أننا في بحث علميّ. إنّنا بحاجة إلى دراسة الصور وسماتها والعلاقات بينها وبالأخص بين أصولها، وذلك عبر النظر إليها مباشرة مع تجنّب المقارنة الدائمة مع الواقع، ومن شأن هذا أن يتيح لنا اكتشاف احتمالات لا حدّ لها قد كانت مخفيّة في هذه الصور.
كما أنّه من غير الممكن في الدراسة الأركيولوجية للصور النظر إلى الوقت أو الزمن بطريقة خطيّة أو من منظور واحد، وإنّما يلزم النظر إليها باعتبار الأبعاد المتعدّدة التي يحملها. وهذا ما يتيح المجال لأيّ عمل معنيّ بدارسة الصور والبحث فيها لاستكشاف الماضي والحاضر والمستقبل وما وراءه في آن معًا.
***
أحاول في عملي تفكيك رموز أنظمة ثابتة تعمل دومًا على حبس الناس في مناطق حدوديّة، وقد أفضى بي هذا البحث خلال الوقت إلى رؤية الصورة الأكبر، ففي كل سلسلة عملت عليها كنت أبدأ من عمليّة بحث بصري في محاولة للخروج من حالة ذهنية كنت أعيشُها. سيما أنّ تركيزي كان منصبّاً لسنوات عديدة على قضية المنفى والاغتراب.
لقد قمت بتحويل هذه الحالة الذهنية إلى إشكالٍ أو سؤال بصري، سيقودني بمجرّد حلّه إلى حالة ذهنية أخرى تمثّل تحديًّا بصريًّا جديدًا. فحين أعيد النظر إلى أعمالي، أشعر أنني كنت أقلّبُ هذه الطروسِ البصريةِ التي تستكشفُ طبقاتٍ متعدّدة من ماضٍ عشته، والتأثير الذي أدّاه هذا الإدراك على "واقعي". أما اليوم، فقد تحررت صوري وسائر أعمالي الفنية من روايتي. لعلّ الحكاية الأصليّة ما تزال ماثلةً فيها، غير أنّها ستظهر بطريقة مختلفة، والآن أودّ أن أترك الفرصة للمشاهد ليكشف معاني الأعمال بنفسه.
لقد اختلف إدراكي، وأعتقد أنّ الوقت قد حان كي ننخرط أكثر في عملية النّظر إلى حيث يقبع المعنى في ذهن المشاهدين وفي خيالاتهم. إن هذا ما يجعل تجربة مشاهدة الفنّ تجربة آسرة، ويفسّر كيف نجد أنفسنا أحيانًا غارقين في عملٍ فنّي ما. وكما قال لورنس فاينر: "لا ينضوي العمل على أي استعارة، ولأنه كذلك، فإنّك تتركه متاحًا للناس كي يستخدموه بما يناسب حاجاتهم ورغباتهم. إنّ الفنّ ليسَ للتلقينِ".
كم مرة ذهبنا إلى متحف أو معرض ورحنا ننظر أولَ ما ننظر إلى النص التوضيحيِّ محاولين استكناه السياق أو النظريّة؟ ولكن، ماذا عن النظر إلى الفنِّ نفسِه، فهذا فنٌّ بصريٌّ في المقام الأول. لا بدّ من تحرير الفنّ من النصّ في أحيان كثيرة.
إنّ أي شيء كتبته عن الفنّ الذي قدّمته في الماضي لم يعد له وزنٌ الآن، فهل لك أن تتصوّر معنى ما كتبته بعد مئة سنة من اليوم؟ والأمر ذاته ينطبق على جميع بيانات الفنانين.
إنّ المعارض التي لا تقدّم سوى الحدّ الأدنى من النصوص التوضيحيّة تثير خيال القارئ، بينما تؤدّي قراءة النصّ أوّلًا إلى تحميل قصد الفنّان ولو بشكل مؤقت على العمل الفنّي، مع أنّ هذه المقاصد تمثّل أهمّية للفنّان نفسه وحسب. فحين يبدع الفنّان صورة ما، فإنها تصبح منفصلة عن أي قصد كان بمجرّد عرضها. إنّ للصورة حياةً بذاتها، وإن معناها يعتمد على مستوى المعرفة البصريّة التي يمتلكها الناظر إليها.
في ثلاثينيات القرن الماضي قال والتر بنيامين: "إنّ أمّية المستقبل كما يرى أحدُهم ليست هي الجهل بالقراءةِ أو الكتابة، وإنما الجهلُ بالتصوير." ويبدو أنّ هذه العبارة قد أثبتت صحّتها رغم انقضاء قرابة قرنٍ عليها.
السؤال المطروح هو التالي: "هل للسياق الذي تشكّل فيه الفنّ أي اعتبار؟ إن كان الموسيقار قد مرّ في حالة إلهام حين ألف مقطوعة موسيقيّة ما، فهل يحتاج المستمع حين يستمع إليها أن يعرف عن قصّة هذا الإلهام؟ وبينما يبدو هذا المفهوم واضحًا حين يتعلق الأمر بالموسيقى، فإننا نجد أنّه يضيع في حالة الفنون البصريّة.
يجدر بنا النظر إلى الفنّ بأعيننا بدلًا من محاولة العثور على المعنى من خلال النصوص. إن علينا إذن أن ننظر كما نحبّ أن نستمع، وأن نستمتع بما يأتي، ونترك ما لا يروقنا، وأن نذهب إلى ما هو أعمق مستكشفين إيقاعات وطبقات ما نراه وما نستمتع به. هذه هي الرحلة البصريّة التي عادة ما أشير إليها.
في العام 2014 انتهيت من مجموعة "سينوبيا" كي تعرض في متحف البحرين الوطني. وللتعريف، "سينوبيا" هي مسودة الرسم الموجودة أسفل اللوجة الجصية (fresco). إنني أرى في "سينوبيا" الطبقة غير المرئية أو المخفيّة التي تظهر الطرس من زاوية مختلفة.
لقد صوّرتُ المنامة من كلّ زاوية، من 360 درجة، ثم بَسَطت هذه المشاهد التي التقطتها للمدينة، فتشكّل لديّ إيقاع ما وتردّدٌ صوتيّ يمثّل ما أراه أو أسمعه حين أحاول تفسير البحرين، وبعدها طلبت من فرقة "مشروع خوري" أن يحولوا هذا الإنتاج البصري إلى سمعيّ.
أما في القطعة الثانية في سينوبيا، فقد قمت بتصوير رسوم الجرافيتي في شوارع البحرين، وقمت بصف طبقات الجرافيتي فوق بعضها، ثم بدأت بمحوها، وصرت كلّما محوت طبقة اكتشفت أخرى، وكان ذلك بالنسبة لي عمليّة تتيح الوصول إلى نقاط أعمق وأعمق وصولًا إلى الصميم.
وقد ساعدت عملية الكشف هذه في الاستمرار في التنقيب عن المستور وغير المكشوف من الطروس البصريّة. وبما أنّ صور الجرافيتي كانت من طبقات متعدّدة وممسوحة، فإن إعادة ترتيب نحوها البصريّ، يوصل بحثي في كشفِ طروس بصرية.
وكانت النتيجة أن تحوّل صوت الناس إلى إيقاع وإلى انفجار بصريّ.
***
كل شيء يحيط بنا محكوم بأعراف ومفاهيم، والكثير من الناس يعتبرون هذه الأنظمة من المسلمات. وقد كان نصيبي أن أنشأ في منطقة معروفة بصعوبة رموزها، وكنت أسعى من أجل أن أتحرّر من ذلك النظام، وهو نظام وسمني بشكل تلقائي بأنني شخص أعيش تحت الاحتلال الإسرائيلي.
كنت قد سألت نفسي من قبل عمّا كان يحول دون شعوري بالحريّة، وما الذي كان يمنعني من الوقوف وحدي؟ ثم وجدت أن بحثي عن أصل الصور ووظائفها قد ساعدني على العثور على حريتي. حرّرت نفسي من الاحتلال والمنفى الذي ترتّب عليه، أو حرّرت نفسي بالأحرى من صورة الاحتلال والمنفى من خلال اللجوء إلى الصور والاستعانة بالمخيلة.
لا وجود لشيءٍ يدعى "مجلس الحريّة" من شأنه أن يخلع الحريّة على أحدٍ أو عنه. جلّ ما نحتاج إليه هو الخيال الذي يساعدنا على أن نعرف أنفسنا ونحدد ما نبحث عنه، فكلّ فرد مسؤولٌ عن أن يحرر نفسه من هذا النوع الجديد من الاستعمار الذي أثّر بالنّاس من دون أن يشعروا به ولا يتنبهوا له، إنّه استعمار المخيلة، حيث تستخدم الأنظمة الصور لاختراق الأذهان والتأثير بها.

إن الشعب الفلسطيني ليس بحاجة إلى الأمم المتحدة ولا إلى الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة أو غيرها من دول العالم، ناهيك عن إسرائيل، كي تعلن لهم أنّهم أحرار. لقد ولدنا جميعنا أحرارًا.
باختصار، إذا لم يمكننا التخيل بأننا أحرار، كيف يمكننا أن نحرّر الأرض؟
غير أنّي سرعان ما اكتشفت أنني أصبحت في أسر صور أخرى، كصورة الفنّان مثلًا، فوجدت نفسي في رحلة أتحرر خلالها من الفنّ. فالحياة عملية لا تنتهي من التحرّر، ونحن في حاجة دومًا إلى معرفة تلك الأنظمة التي تحتل أذهاننا وأخيلتنا كي نتحرّر من قيدها ونتمكن من التفكير والتخيّل بطريقتنا نحن.
عام 2012 انطلقت في رحلة من برلين إلى كرواتيا، ولأول مرّة وجدت نفسي أتفاعل مع الفنّ بدون مفهوم أو تصوّر مسبق في مخيلتي، وفي تلك اللحظة تشكّل هذا المشروع، ومن أجل القيام به كان عليّ أن أتحرّر من التقنية ومعدات الكاميرا. كانت تلك هي الحريّة بالنسبة لي.
***
أما في عملي القادم فسأقوم بعرض صورة القدس على حائط في واحد من كهوف المدينة القديمة، أي أنني سأحول الكهف إلى غرفة تحميض من خلال وضع محلول تصوير حساس للضوء على واحد من الجدران وإسقاط ضوء صورة القدس على هذا السطح. وحتى بعد تثبيت الصورة باستخدام العملية الكيميائية، فإنها ستختفي يومًا ما، لأن المحلول سيجفّ بعد عدّة سنوات وينقشع.
ورغم معرفتنا بأن هذه الصورة- صورة القدس- ستختفي حتمًا من الكهف، إلا أنّها ستبقى قائمةً بأشكال متخيّلة أخرى لا حدّ لها كالصور الفوتوغرافية والأفلام وفي الذاكرة أيضًا. كلّ واحدٍ منكم قد شكّل هذه الصورة في ذهنه، ومن هنا ندرك أن الصورة لا تموت أبدًا، وإنما تنتقل من شكل إلى شكل آخر.

إن ما نحتاج إليه هنا هو أن نبحث فيما كان قبل الكهف - أي علينا أن نذهب إلى أصل سلالة الصورة. إن التاريخ البصريّ للصورة في الكهف قد بدأ قبل مرحلة طويلة من إسقاطي لها على جداره. فلنحاول أن نتتبّع هذه الصورة ومن أين أتت.
إن الإسقاط كما تعلمون هو صورة، ومصدر هذا الإسقاط هو صورة للقدس. فهل ما تمثّله الصورة موجود حقيقة بشكل ماديّ؟ ما الذي يؤكّد أن لا تكون القدس صورة أُوجدت أو كشفت، كتلك الصورة الموجودة على جدار الكهف؟ ما مصدر جميع هذه الصور؟ وهكذا ندرك أن الصورة والإدراك داخلان في طبقان متعدّدة، وأننا نعيش في عالم ينضوي على عدد غير متناهٍ من الطروس البصريّة.
كما أنّ هذا المشروع لا يتطلّب منّي بالضرورة أن أعودَ إلى الكهف في القدس لأجعل منه غرفة تحميض، رغمَ أنني قد أفعل. ولكنّ الخيال قد أقام المشروع بالفعل وجعل منه حقيقة مادّية، ويؤكّد هذا من أقوله الآن أمامكم، إذ يمكننا الآن الحديث عن دلالات المشروع والمعاني التي يحملها، فهو لذلك ذو طبقات متعدّدة بالفعل. كما أنّ الناس قد تفاعلوا مع المشروع حتى قبل تحقّقه على الواقع. فالذهن قادر على استكشاف المكان حتى بغياب المكان. هذه هي أركيولوجيا المستقبل، إنّها الانتقال عبر الصورة والخيال.
إننا ما نزال في المراحل الأولى من اكتشاف قوّة الصور الفوتوغرافية، وحين نفصل ما نراه عمّا تمّ تصويره (أي "عالم الواقع")، فإننا نجد أنفسنا في غِمار عملية أكثر عمقًا من النظر. ولو قام كلّ إنسان على هذه الأرض بالنظر إلى الصورة ذاتها لحصلنا على عددٍ لا حصر له من التفسيرات لها. فالتصوير واسطة تتشكّل فيها طروس بصرية لا متناهية.
علينا أن نفكّر بالصورة الفوتوغرافية كنجمة مضيئة لم تكتشف بعد في المجرّة، وكلّ ما نعرفه عن النجمة يرد من تفسيراتنا المتعلقة بظاهرها اللامع، تمامًا كما في الصورة، إلا أنّ هنالك الكثير مما يبقى لنراه ونكتشفه. وباختصار، فإن علاقتي مع الصورة هي أشبه برحلة فضائية بحثًا عن فهم تشكّلها. وبما أنّ الصورة هي جزء من الخيال، فإن فك الرموز البصريّة سيتيح لنا أن نرى ما هو متجاوز للواقع.
***
لا بدّ من انتزاع التصوير من المفاهيم الأصلية التي تحيط بها، كالرغبة البشريّة في تثبيت الصور والهوس بأخذ صور دقيقة عن العالم كما هو. ولكن لعلّنا بتنا في مرحلة تتيح لنا تفكيك الصور بحيث لا تكون مرهونة بالوجود على ورقة أو شاشة، فتحرر من الزمن وتطوف حرّة في خيالاتنا.
***
ختامًا، أودّ أن أقول إنني قد تقبّلت فكرة المنفى بعد عملية طويلة من التأمّل والتحقيق والاستجوابِ الذاتي. وقد تناول فيليم فلوسر قضيّة المنفى فقال: "يصبح المهاجر حرًّا ليس حين يتنكر لوطنِه الأصليّ، وإنمّا حين يتمكّن من تقبّلِه".
لم أرغب قطّ في تغيير جيناتي، فأنا أصلي دومًا من القدس، ولكن ما قد يتغيّر هو الوعي والإدراك. ومن خلال النظر في المنفى من زوايا متعدّدة وتوجّهات مختلفة تمكّنت من الغوص عميقًا في العلاقة بين الصور والواقع الذي تخلقه. وهكذا صرت حرّاً.
لقد جعلني بحثي هذا أصدّق أنّ عالمنا يتألّف من عدد لا محدود من الطروس البصريّة المخفيّة في طبقات مثبتة. وإنني أسعى إلى أن أقدّم فنًّا ذا صلة بالتاريخ البصريّ. إن أوهامي عبارة عن جسور متخيّلة، أشبه بالخرائط البصرية، تساعد على ربطنا بماضينا بعين على المستقبل.
لقد حان الوقت لنخوض أكثر في عمليةٍ من النظر إلى العلاقة بين الصّور والتاريخ البصريّ. علينا أن نتوقف عن التفكير بالزمن والتاريخ بطريقة خطيّة، فالصور قادرة على نقلنا إلى الماضي، والحاضر، والمستقبل وما وراء ذلك. إننا نشكّل رحلاتنا بأنفسنا، هذه الرحلات التي تأخذنا نحو الخيال حيث كلّ شيء نتخيّله يصير حقيقة.
* مقاطع من محاضرة للفنان يقدّمها ضمن جولة في القدس وبيت لحم ورام الله وحيفا وغزة بين 3 و11 أبريل/ نيسان الجاري. الترجمة عن الإنجليزية محمد زيدان