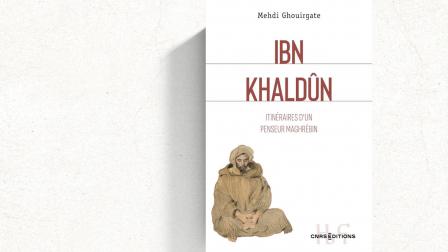لوحة للفنان بول سينياك (Getty)
بأسرع مما تخيل المرء، قفزت مقارنات عفوية بين وضع سورية، بعد خمس سنوات ونيف من "الربيع العربي"، ووضع فلسطين كما نعرفه من مأساة مستمرة، لكن من الممكن ضمها في رواية متناسقة تقول على الأقل من الضحية ومن الجلاد، خلافًا للمأساة السورية التي لا تملك رواية متناسقة ومتفقاً عليها. الفروق الزمنية من جهة، وقوة الإعلام وتعقّد الاستراتيجية السياسية من جهة أخرى، أطاحت بفكرة الرواية المشتركة المتناسقة للسوريين، وحلت محلها "سردية" غير مترابطة وغير خطية زمنيًا لمجموعة من النكبات، التي تركز على التهديم المهول في المكان، وحركة التهجير الداخلي والقسري أيضًا لجزء كبير من السكان، تقريبًا نصف السكان، فضلًا عن تحول البلد إلى "مصنع" للمقاتلين والإرهابيين من جنسيات مختلفة. أدى الإعلام الحديث القائم على النقل المباشر للحدث، فضلًا عن دور وسائل التواصل الاجتماعي أيضًا، دورًا هائلًا في "الخلط" وتسهيل الاستقطابات من دون توضيح، بل ربما مع التعمية على تعقّد الاستراتيجية السياسية لأطراف فاعلة في المشهد السوري، تحكمها بالدرجة الأولى مصالحها. المصالح التي يرتبط فيها النفوذان السياسي والاقتصادي بشكل وثيق. من الممكن اختزال ذلك كله، بلفظ القيامة، حيث التغيير لا يمكن الرجوع عنه على ما يبدو.
مع ذلك، فإن المقارنة بين سورية وفلسطين، التي كانت ممكنة منذ قليل، لم تعد اليوم كذلك، إذ إن المشهد الفلسطيني، حافظ على سردية اختزالية تقول من الضحية ومن الجلاد، خلافًا للمشهد السوري حيث الضحية هي الشعب السوري، أما الجلادون فكثر. ناهيك عن ذلك التدمير الهائل والمرعب في المكان السوري، وهو تدميرٌ منهجي يخبّر عن كل ما هو ضد العمران حجرًا وبشرًا، تعليمًا وصناعة.
لكن بعيدًا عن القدرة على تصور الطابع الاختزالي لما جرى ويجري في فلسطين، وانتفاء تصور ذلك بالنسبة لسورية، يجدر القول إن تحت الطابع الاختزالي منظومة معقدة من الوقائع التي أدّت إلى مآل فلسطين اليوم. من بينها، التفاوت الحضاري بين الفلسطينيين وأولئك "الأوروبيين" القادمين من جهة البحر. فالمشهد عشية النكبة، وفقًا لما يصوره ضيف ملحق الثقافة المميز، لهذا العدد، المؤرخ الفلسطيني اللامع رشيد الخالدي، مؤطر أكثر مما نتصور بالتفاوت الحضاري. تفاوت سيغدو بعد سنوات قليلة فواتًا حضاريًا، وبعد اتفاق أوسلو تحديدًا، حين يتضح مثلًا دور المنظمات غير الحكومية، مدججة بسلطة المانحين، كقوة "ناعمة" في جعل فكرة تعايش الازدهار الاقتصادي (الافتراضي بالطبع) مع الاحتلال في رام الله مثلًا أمرًا مقبولًا. ثمة شيء من التدجين، وشيء من الحصاد المرّ، نتيجة زراعة مشوهة.
القصد، إنه سواءٌ اقترب المرء من فلسطين بعدسة مكبرة ليرى التفاصيل، أو ابتعد ليرى المشهد مختزلًا، فإن النتيجة واحدة. مع ذلك، فإن "الفائدة" إن جاز التعبير، تكون في الاقتراب من أجل التخفف من "إنكار الواقع"، الذي ألبس فلسطين ثوبًا زخرفيًا، سمح للآخرين بـ "التغني" بالدفاع عنها فحسب، من دون تقديم دعم جدي مثمر ومؤثر في النهاية.
والاقتراب سواء من فلسطين أو من سورية بعدسة مكبرة، يعني حكمًا كتابة البحث العلمي، وتنمية التفكير النقدي، والتمتع بـ "النزاهة الفكرية" إن جاز التعبير. فهي أمور من شأنها أن تقلل من الفوات الحضاري الهائل الذي نعيش في خضمه، إذ ليس سرًا أن الجهود الفردية الممتازة لدى الفلسطينيين والسوريين في ميادين شتى، تمتلك تأثيرًا بسيطًا، نظرًا إلى "تناثرها" هنا وهناك، بعيدًا عن تأطير مركزي يسمح لها بالتراكم والتأثير. ففي أي مكان في العالم العربي، يستطيع مؤرخ ما أن يكتب بحرية وبالاستناد إلى أرشيف ووثائق، عن موضوع سيعدّ "ساخنًا" إذ يتطرق فيه لعمل ودور أحد رجالات السلطة في بلد ما في أمر محدد وحيوي ومعاصر؟
وفي المقابل الآخر، حيث إسرائيل، يكتشف المرء كل يوم مظهرًا من مظاهر غطرستها القائمة على القوة صحيح، لكن أيضًا على المعرفة. فقد أفردت صحيفة "فاينانشال تايمز" مؤخرًا مقالًا، للحديث عن "السور الجديد" فائق التقنية الذي يفصلها عن مصر. وضعت إسرائيل كل معرفتها التكنولوجية، لبناء هذا السور الشبكي اللامعدني، المجهز بلواقط وحساسات مربوطة بأجهزة كومبيوتر لدى جيش الاحتلال. يكفي أن يقترب حيوان ما من السور، حتى يعرف الجنود، ويقومون بما يلزم. المهم في الأمر، أن المرشح لرئاسة الولايات المتحدة، دونالد ترامب، أعجب بـ "الابتكار الإسرائيلي"، وفكر كأي رجل أعمال بالطبع، بحيازة واحد مماثل، إذ يريد استعماله بين الولايات المتحدة والمكسيك.
اقــرأ أيضاً
مع ذلك، فإن المقارنة بين سورية وفلسطين، التي كانت ممكنة منذ قليل، لم تعد اليوم كذلك، إذ إن المشهد الفلسطيني، حافظ على سردية اختزالية تقول من الضحية ومن الجلاد، خلافًا للمشهد السوري حيث الضحية هي الشعب السوري، أما الجلادون فكثر. ناهيك عن ذلك التدمير الهائل والمرعب في المكان السوري، وهو تدميرٌ منهجي يخبّر عن كل ما هو ضد العمران حجرًا وبشرًا، تعليمًا وصناعة.
لكن بعيدًا عن القدرة على تصور الطابع الاختزالي لما جرى ويجري في فلسطين، وانتفاء تصور ذلك بالنسبة لسورية، يجدر القول إن تحت الطابع الاختزالي منظومة معقدة من الوقائع التي أدّت إلى مآل فلسطين اليوم. من بينها، التفاوت الحضاري بين الفلسطينيين وأولئك "الأوروبيين" القادمين من جهة البحر. فالمشهد عشية النكبة، وفقًا لما يصوره ضيف ملحق الثقافة المميز، لهذا العدد، المؤرخ الفلسطيني اللامع رشيد الخالدي، مؤطر أكثر مما نتصور بالتفاوت الحضاري. تفاوت سيغدو بعد سنوات قليلة فواتًا حضاريًا، وبعد اتفاق أوسلو تحديدًا، حين يتضح مثلًا دور المنظمات غير الحكومية، مدججة بسلطة المانحين، كقوة "ناعمة" في جعل فكرة تعايش الازدهار الاقتصادي (الافتراضي بالطبع) مع الاحتلال في رام الله مثلًا أمرًا مقبولًا. ثمة شيء من التدجين، وشيء من الحصاد المرّ، نتيجة زراعة مشوهة.
القصد، إنه سواءٌ اقترب المرء من فلسطين بعدسة مكبرة ليرى التفاصيل، أو ابتعد ليرى المشهد مختزلًا، فإن النتيجة واحدة. مع ذلك، فإن "الفائدة" إن جاز التعبير، تكون في الاقتراب من أجل التخفف من "إنكار الواقع"، الذي ألبس فلسطين ثوبًا زخرفيًا، سمح للآخرين بـ "التغني" بالدفاع عنها فحسب، من دون تقديم دعم جدي مثمر ومؤثر في النهاية.
والاقتراب سواء من فلسطين أو من سورية بعدسة مكبرة، يعني حكمًا كتابة البحث العلمي، وتنمية التفكير النقدي، والتمتع بـ "النزاهة الفكرية" إن جاز التعبير. فهي أمور من شأنها أن تقلل من الفوات الحضاري الهائل الذي نعيش في خضمه، إذ ليس سرًا أن الجهود الفردية الممتازة لدى الفلسطينيين والسوريين في ميادين شتى، تمتلك تأثيرًا بسيطًا، نظرًا إلى "تناثرها" هنا وهناك، بعيدًا عن تأطير مركزي يسمح لها بالتراكم والتأثير. ففي أي مكان في العالم العربي، يستطيع مؤرخ ما أن يكتب بحرية وبالاستناد إلى أرشيف ووثائق، عن موضوع سيعدّ "ساخنًا" إذ يتطرق فيه لعمل ودور أحد رجالات السلطة في بلد ما في أمر محدد وحيوي ومعاصر؟
وفي المقابل الآخر، حيث إسرائيل، يكتشف المرء كل يوم مظهرًا من مظاهر غطرستها القائمة على القوة صحيح، لكن أيضًا على المعرفة. فقد أفردت صحيفة "فاينانشال تايمز" مؤخرًا مقالًا، للحديث عن "السور الجديد" فائق التقنية الذي يفصلها عن مصر. وضعت إسرائيل كل معرفتها التكنولوجية، لبناء هذا السور الشبكي اللامعدني، المجهز بلواقط وحساسات مربوطة بأجهزة كومبيوتر لدى جيش الاحتلال. يكفي أن يقترب حيوان ما من السور، حتى يعرف الجنود، ويقومون بما يلزم. المهم في الأمر، أن المرشح لرئاسة الولايات المتحدة، دونالد ترامب، أعجب بـ "الابتكار الإسرائيلي"، وفكر كأي رجل أعمال بالطبع، بحيازة واحد مماثل، إذ يريد استعماله بين الولايات المتحدة والمكسيك.