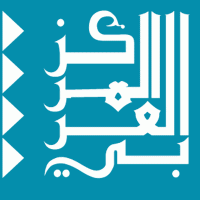18 نوفمبر 2024
تشكيل حكومة الكاظمي في العراق .. تحول فعلي أم تسوية عابرة؟
مصطفى الكاظمي يقدم برنامج حكومته لمجلس النواب (6/5/2020/ الأناضول)
نجح رئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي، مصطفى الكاظمي، في تشكيل حكومة حازت ثقة مجلس النواب العراقي في 7 أيار/ مايو 2020، بعد أن فشل قبله محمد توفيق علاوي وعدنان الزرفي، وذلك بعد أزمة سياسية استغرقت أكثر من سبعة أشهر، جاءت إثر احتجاجات واسعة في مدن الوسط والجنوب، ودفعت برئيس الحكومة السابق عادل عبد المهدي إلى الاستقالة.
تغيير في قواعد اللعبة
يعدّ منح الثقة لحكومة مصطفى الكاظمي اختراقًا لقواعد العمل السياسي التي عرفها العراق منذ الغزو الأميركي، وسقوط نظام الرئيس صدام حسين؛ فالكاظمي هو أول شخص يشغل منصب رئيس الحكومة لا يأتي من قيادات الأحزاب التي سيطرت على السلطة عام 2003. كما أنه أول رئيس حكومة له ميول ليبرالية واضحة، وعلاقات قوية بالغرب، بحكم عمله الطويل مع المعارضة العراقية خلال تسعينيات القرن الماضي. ويمكن القول إن الكاظمي يشير إلى ولادة الجيل الثاني من السياسيين الشيعة. ومع أن هذا الجيل نشأ في الحاضنة الإسلامية، فإنه تحوّل ليصبح أكثر براغماتية، وأكثر ليبرالية، على الرغم من الوشائج التي كانت تربطه بالمنظومة الإسلامية الشيعية التقليدية.
وقد قام رئيس الوزراء السابق، حيدر العبادي، بدور رئيس في إبراز هذا الجيل الذي ينتمي إليه أيضًا المرشح السابق لرئاسة الحكومة، عدنان الزرفي؛ فالعبادي، وهو من قيادات الخط الثاني في حزب الدعوة، هو الذي رشّح الكاظمي الشاب نسبيًا (مواليد عام 1967) لمنصب رئيس جهاز المخابرات عام 2016، وتربط الرجلين علاقة مصاهرة وقرابة.
لهذه الأسباب وغيرها، ظل الكاظمي محلّ شكوك القوى السياسية المقرّبة من إيران التي عارضت ترشحه للمنصب أكثر من مرة عندما كان اسمه يُطرح بين المرشحين. والواقع أنه ما كان ممكنًا للكاظمي أن يصل إلى رئاسة الحكومة، لولا تغير المشهد السياسي العراقي بفعل حركة الاحتجاجات الواسعة التي انطلقت في تشرين الأول/ أكتوبر 2019، إضافة إلى تحوّلات إقليمية ودولية، كان العراق في قلبها، خصوصًا منذ التصعيد الإيراني - الأميركي في الخليج الصيف الماضي، وصولًا إلى تصفية قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، اللواء قاسم سليماني، في مطار بغداد مطلع عام 2020.
الرئيس يوظف القواعد المتغيرة
جاءت استقالة حكومة عادل عبد المهدي في أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر 2019 استجابةً
للضغوط الشعبية ومطالب الحركة الاحتجاجية. وقد ساندتها في ذلك مرجعية النجف التي ساءها سقوط مئات القتلى برصاص قوى الأمن والمليشيات المحسوبة على إيران. وقد طالب المرجع الشيعي، علي السيستاني، البرلمان باختيار رئيس وزراء جديد "غير جدلي"، ويقبل به المتظاهرون الذين كانوا قد تمكّنوا في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019 من بلورة مجموعة مطالب، سرعان ما تبنّتها قوى سياسية ومراجع دينية ونخب فكرية، كما حظيت بدعم الأمم المتحدة. وكان من أهم المطالب استقالة حكومة عادل عبد المهدي المتهمة بالتغاضي عن قتل مئات الناشطين، وتشكيل حكومة انتقالية مؤقتة، مهمتها الأساسية تنظيم انتخابات مبكّرة ونزيهة بإشراف دولي لمنع التلاعب والكشف عن قتلة الناشطين.
استفاد الرئيس برهم صالح من هذه الأجواء لتغيير قواعد اللعبة السياسية المستمرة منذ عام 2003، فأعلن رفضه ما لا يقل عن ثلاثة مرشحين أساسيين لخلافة المستقيل، عادل عبد المهدي، كانت كتل نيابية مقرّبة من طهران طرحت أسماءهم في البرلمان. وعلى الرغم من أن موقف الرئيس استفز أطرافًا شيعية كثيرة لم تكن تتخيل أنّ بإمكان الرئيس تحدّيها، تمسّك صالح بموقفه مستندًا إلى قوة الشارع، فأعلن أنه لن يستطيع تكليف مرشّحٍ لا ترضى عنه حركة الاحتجاج.
جاء الرفض الأول من رئيس الجمهورية في 13 كانون الأول/ ديسمبر 2019 للمرشح محمد شياع السوداني الذي قدّمه تحالف الفتح، الذراع البرلمانية للمليشيات المقرّبة من إيران. وفي 22 كانون الأول/ ديسمبر، رفض رئيس الجمهورية ترشيح قصي السهيل الذي شغل سابقًا منصب وزير التعليم العالي، وفي 26 من الشهر نفسه رفض الرئيس ترشيح أسعد العيداني، محافظ البصرة، لتشكيل الحكومة.
والواقع أنه لم يكن لرئيسٍ ينحدر من كردستان، ويفتقر إلى قاعدة الدعم اللازمة لخوض مواجهة كهذه مع قوى شيعية نافذة، لولا أن أطرافًا أخرى دخلت على الخط انحيازًا إلى حركة الاحتجاج، مثل مرجعية النجف التي أيدت مطلب تكليف رئيس حكومة مستقل، تكون مهمته الرئيسة تنظيم انتخاباتٍ نزيهةٍ بإشراف دولي. وقد أصرّت مرجعية النجف على هذا المطلب، على الرغم من رفض طهران له، لأنه سيؤدي عمليًا إلى تغيير موازين القوى لصالح الحركة الاحتجاجية، وتقليص تمثيل القوى السياسية والمليشيات القريبة منها، والتي حظيت بمقاعدَ أكبر من حجمها في انتخابات عام 2018، بتأثير أجواء الانتصار على تنظيم الدولة الإسلامية (داعش). وقد نشر الرئيس صالح خطابًا مطولًا وجّهه إلى البرلمان في 26 كانون الأول/ ديسمبر، قال فيه إنه يفضل الاستقالة على القبول بمرشح يرفضه المحتجون.
ومع إصرار الرئيس، مسنودًا بموقف الحركة الاحتجاجية ومرجعية النجف، على رفض مرشحين
محسوبين على طهران، جرى تكليف ثلاثة مرشحين يمكن وصفهم بأنهم غير قريبين من إيران في الفترة من شباط/ فبراير حتى نيسان/ أبريل 2020. سقط أولهم (محمد توفيق علاوي) نتيجة اعتراض سني كردي على تجاهله لهم، وسقط الثاني (عدنان الزرفي) باعتراض شيعي، لأنه جاء مرشحًا من رئيس الجمهورية من دون مشاوراتٍ مع الكتل الشيعية ذات الأغلبية، إلى أن نجحت أخيرًا ظروف استثنائية في جعل المكونات الثلاثة توافق على خوض حوار جدّي مع المرشح مصطفى الكاظمي.
ففي الأول من شباط/ فبراير 2020 كلف رئيس الجمهورية الوزير السابق، محمد توفيق علاوي، بتشكيل الحكومة، لكن الرجل اضطر إلى الانسحاب في الأول من آذار/ مارس، بعد أن فشل البرلمان على مدى يومين في تحقيق النصاب اللازم لمنحه الثقة، كما قدّم الطرفان، الكردي والسني، اعتراضًا جوهريًا على صيغة الحكومة، لأنها لم تتضمن حصصهم الحزبية.
وفي 17 آذار/ مارس كلف رئيس الجمهورية النائب عدنان الزرفي، وهو محافظ النجف السابق الذي يرتبط بعلاقة قوية مع واشنطن، ويدعم منظماتٍ شبابية تناوئ الأحزاب الدينية. وقد مثل ترشيحه تحدّيًا كبيرًا لمعظم القوى السياسية الشيعية التي وجدت أنّ "حقها" في ترشيح رئيس الحكومة يصادره رئيس الجمهورية. أما القوى السياسية الكردية والسنية فقد التزمت الحياد، معتبرة أن مسؤولية تسمية رئيس الحكومة تعتمد على توافق ما يسمى "البيت الشيعي"، وهو ما أدّى إلى انسحاب الزرفي، وتكليف الكاظمي في 9 نيسان/ أبريل 2020.
تغير في الموقف الإيراني
مثلت موافقة البرلمان على منح الثقة لحكومة الكاظمي مفاجأة لكثيرين، ذلك أن الكاظمي كان حتى قبل أيام من جلسة منح الثقة محل رفض شديد من حلفاء طهران، بل إن المليشيات الشيعية
واظبت، منذ اندلاع احتجاجات تشرين الأول/ أكتوبر 2019، على اتهامه بالتحضير لانقلاب يوصله إلى السلطة. كما أثيرت شائعاتٌ وتساؤلاتٌ بشأن مسؤوليته بوصفه رئيسًا لجهاز المخابرات، أو حتى تورّطه، في تسهيل اغتيال قاسم سليماني في مطار بغداد.
ويرجع التغيير في موقف بعض القوى السياسية الشيعية من منح الثقة لحكومة الكاظمي (ظل ائتلاف دولة القانون برئاسة رئيس الحكومة الأسبق نوري المالكي على موقفه الرافض لها) إلى تغيير في موقف طهران التي فاجأها حجم الاحتجاجات الرافضة لتدخلها في شؤون العراق، خصوصا في مدن الوسط والجنوب ذات الغالبية الشيعية، حيث استهدف المحتجّون رموز إيران وحلفاءها في العراق، بما فيها قنصلياتها، في صعود لافت للشعور الوطني المُطالِب بعدم توريط العراق في أزمات دولية لصالح إيران.
وقد جاء ترشيح أسماء بعيدة عن طهران مؤشرًا على تحوّل كبير في قواعد اللعبة فرضته الحركة الاحتجاجية. وقد دفع ذلك قوى سياسية قريبة من إيران إلى إعادة حساباتها، مخافة أن تدفع الثمن في الانتخابات القادمة. أما إيران فما كان لها أن تستمر في رفض المرشحين إلى ما لا نهاية، بعد أن تحفظت على توفيق علاوي ورفضت عدنان الزرفي. وقُرئ ذلك أيضًا أنه إشارة إلى محاولات إيرانية للوصول إلى تسويةٍ تمكّن من مواصلة حكم العراق، أو للتهدئة مع واشنطن التي بدا أنها تقف بقوة وراء الكاظمي.
تشكيلة الحكومة
اختار الكاظمي في تشكيلة حكومته شخصياتٍ من داخل حركة الاحتجاج أو قريبة منها، وتعهد بتلبية مطالبها، على الرغم من عدم وضوح فرص نجاحه في ذلك، خصوصا بشأن الكشف عن قتلة المتظاهرين. ويبدو أن الكاظمي أراد من خلال ضمّ شخصيات في الحراك إلى حكومته أن يُقنع الكتل النيابية بأنّ الطريق الوحيد لإنقاذ النظام من الانهيار يتمثل في الاستجابة لمطالب الشارع. ولكن الخلافات بدت أعمق من مجرّد توزيع حقائب وزارية، ويتعلق الأمر خصوصًا بمخاوف إيران بشأن وضع حلفائها في العراق، والحصانة التي تريد أن تمنحها لهم، فضلًا عن مستقبل العلاقات بين بغداد وواشنطن، بينما يرفض الكاظمي تقديم تنازلاتٍ كبيرة. وقد تعزّز موقع الكاظمي، أخيرًا، بعد القرار الذي اتخذه المرجع علي السيستاني بفصل آلاف المقاتلين التابعين للمرجعية عن هيئة الحشد الشعبي وإلحاقهم بوزارة الدفاع. وقد شمل ذلك كتائب الإمام علي، وكتائب علي الأكبر، وفرقة العباس، ولواء أنصار المرجعية.
بعد مفاوضات صعبة، نجح الكاظمي في كسب الثقة لثلثَي وزرائه خلال جلسة استثنائية للبرلمان. لكن مرور الحكومة بشكلها الأخير تسبب في إحباطٍ في صفوف المحتجين، إذ اضطر الكاظمي إلى التضحية بعدد من مرشحيه الوزراء من أصحاب الخبرة والكفاءة المحسوبين على أجواء "انتفاضة أكتوبر". إلا أن خسارة الكاظمي في هذه الناحية يقابلها نجاحه في تعيين ضباط مستقلين عن نفوذ المليشيات الموالية لطهران، في مواقع وزارتَي الداخلية والدفاع، أضف إلى ذلك أن المخابرات وأركان الجيش وجهاز مكافحة الإرهاب، وهو جهاز كوماندوز عراقي مهم، بقيت تابعة عمليًا له. وقد اتخذ الكاظمي، عندما تسلَّم منصبه في رئاسة الحكومة، قرارًا بإعادة الفريق عبد الوهاب الساعدي إلى قيادة جهاز مكافحة الإرهاب، بعد أن أطاحه رئيس الحكومة السابق، عادل عبد المهدي، نتيجة شكاوى المليشيات القريبة من إيران.
تحدّيات تواجه الحكومة
تواجه حكومة الكاظمي تحدّيات كبرى ينبغي لها معالجتها، تتقدمها معالجة تداعيات وباء كورونا
المستجد الذي شلّ البلاد. لكن التحدّي الأكبر يتمثل في انهيار أسعار النفط، إذ ستغدو الحكومة، خلال فترة قريبة، عاجزة عن دفع مرتبات القطاع العام الذي تضخم بشكل كبير خلال العقد الماضي نتيجة المحاصصة بين الأحزاب التي اقتسمت الدولة، ووزّعت الوظائف الحكومية على مناصريها ومحازبيها. فوق ذلك، سيترتب على الكاظمي خوض معركة حصر السلاح بيد الدولة، وهو الهدف الذي أعلن بوضوح أنه يمثل جزءًا من برنامج عمل حكومته، وسوف يدخله هذا الأمر في مواجهة حقيقية مع المليشيات التي تدعمها إيران وشبكة المصالح المرتبطة بها.
سوف يحتاج الكاظمي أيضًا إلى إنشاء توازن في علاقته بطهران وواشنطن، حتى يضمن عدم عرقلة برامجه وسياسات حكومته. وستكون أولى خطواته في هذا الاتجاه إدارة الحوار الاستراتيجي بين واشنطن وبغداد المتوقع انطلاقه الصيف المقبل، حيث سيدرس الطرفان شكل الوجود العسكري الأميركي في العراق ومستويات التعاون، بعد أن فشلت طهران مع حلفائها في إجبار واشنطن على سحبٍ سريع للقوات، في إثر اغتيال سليماني. والأرجح أن يتمكّن الكاظمي من إنقاذ العراق من عزلة مالية ودبلوماسية كانت تحت الدراسة في واشنطن، في ظل اتهام رئيس الحكومة السابقة بأنه خضع أكثر مما ينبغي لنفوذ المليشيات الموالية لطهران.
يحظى الكاظمي في تحرّكه بدعم أطراف وازنة، مثل مرجعية النجف والتيارات والقوى العلمانية والكردية، غير أنّ فئاتٍ مؤثرة في أجواء حراك أكتوبر ترى أن النظام الحالي يعاني خللًا لا يمكن إصلاحه. ولكن، بدا خلال اليومين الأخيرين ميلٌ أكبر لدى المجاميع الشبابية الممثلة لحركة الاحتجاج إلى ضرورة منحه فرصة بوصفه الحل الوسط بين مطالب الحراك ومصالح الأحزاب والقوى المهيمنة على العملية السياسية منذ عام 2003، وأن ذلك قد يمثّل مدخلًا إلى تغييرٍ على مراحل، يكون أقل تكلفة من إسقاط النظام، وعلى أمل أن تؤدّي الانتخابات التي تعهّد الكاظمي بإجرائها إلى تغيير موازين القوى السياسية في العراق.
يعدّ منح الثقة لحكومة مصطفى الكاظمي اختراقًا لقواعد العمل السياسي التي عرفها العراق منذ الغزو الأميركي، وسقوط نظام الرئيس صدام حسين؛ فالكاظمي هو أول شخص يشغل منصب رئيس الحكومة لا يأتي من قيادات الأحزاب التي سيطرت على السلطة عام 2003. كما أنه أول رئيس حكومة له ميول ليبرالية واضحة، وعلاقات قوية بالغرب، بحكم عمله الطويل مع المعارضة العراقية خلال تسعينيات القرن الماضي. ويمكن القول إن الكاظمي يشير إلى ولادة الجيل الثاني من السياسيين الشيعة. ومع أن هذا الجيل نشأ في الحاضنة الإسلامية، فإنه تحوّل ليصبح أكثر براغماتية، وأكثر ليبرالية، على الرغم من الوشائج التي كانت تربطه بالمنظومة الإسلامية الشيعية التقليدية.
وقد قام رئيس الوزراء السابق، حيدر العبادي، بدور رئيس في إبراز هذا الجيل الذي ينتمي إليه أيضًا المرشح السابق لرئاسة الحكومة، عدنان الزرفي؛ فالعبادي، وهو من قيادات الخط الثاني في حزب الدعوة، هو الذي رشّح الكاظمي الشاب نسبيًا (مواليد عام 1967) لمنصب رئيس جهاز المخابرات عام 2016، وتربط الرجلين علاقة مصاهرة وقرابة.
لهذه الأسباب وغيرها، ظل الكاظمي محلّ شكوك القوى السياسية المقرّبة من إيران التي عارضت ترشحه للمنصب أكثر من مرة عندما كان اسمه يُطرح بين المرشحين. والواقع أنه ما كان ممكنًا للكاظمي أن يصل إلى رئاسة الحكومة، لولا تغير المشهد السياسي العراقي بفعل حركة الاحتجاجات الواسعة التي انطلقت في تشرين الأول/ أكتوبر 2019، إضافة إلى تحوّلات إقليمية ودولية، كان العراق في قلبها، خصوصًا منذ التصعيد الإيراني - الأميركي في الخليج الصيف الماضي، وصولًا إلى تصفية قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، اللواء قاسم سليماني، في مطار بغداد مطلع عام 2020.
الرئيس يوظف القواعد المتغيرة
جاءت استقالة حكومة عادل عبد المهدي في أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر 2019 استجابةً
استفاد الرئيس برهم صالح من هذه الأجواء لتغيير قواعد اللعبة السياسية المستمرة منذ عام 2003، فأعلن رفضه ما لا يقل عن ثلاثة مرشحين أساسيين لخلافة المستقيل، عادل عبد المهدي، كانت كتل نيابية مقرّبة من طهران طرحت أسماءهم في البرلمان. وعلى الرغم من أن موقف الرئيس استفز أطرافًا شيعية كثيرة لم تكن تتخيل أنّ بإمكان الرئيس تحدّيها، تمسّك صالح بموقفه مستندًا إلى قوة الشارع، فأعلن أنه لن يستطيع تكليف مرشّحٍ لا ترضى عنه حركة الاحتجاج.
جاء الرفض الأول من رئيس الجمهورية في 13 كانون الأول/ ديسمبر 2019 للمرشح محمد شياع السوداني الذي قدّمه تحالف الفتح، الذراع البرلمانية للمليشيات المقرّبة من إيران. وفي 22 كانون الأول/ ديسمبر، رفض رئيس الجمهورية ترشيح قصي السهيل الذي شغل سابقًا منصب وزير التعليم العالي، وفي 26 من الشهر نفسه رفض الرئيس ترشيح أسعد العيداني، محافظ البصرة، لتشكيل الحكومة.
والواقع أنه لم يكن لرئيسٍ ينحدر من كردستان، ويفتقر إلى قاعدة الدعم اللازمة لخوض مواجهة كهذه مع قوى شيعية نافذة، لولا أن أطرافًا أخرى دخلت على الخط انحيازًا إلى حركة الاحتجاج، مثل مرجعية النجف التي أيدت مطلب تكليف رئيس حكومة مستقل، تكون مهمته الرئيسة تنظيم انتخاباتٍ نزيهةٍ بإشراف دولي. وقد أصرّت مرجعية النجف على هذا المطلب، على الرغم من رفض طهران له، لأنه سيؤدي عمليًا إلى تغيير موازين القوى لصالح الحركة الاحتجاجية، وتقليص تمثيل القوى السياسية والمليشيات القريبة منها، والتي حظيت بمقاعدَ أكبر من حجمها في انتخابات عام 2018، بتأثير أجواء الانتصار على تنظيم الدولة الإسلامية (داعش). وقد نشر الرئيس صالح خطابًا مطولًا وجّهه إلى البرلمان في 26 كانون الأول/ ديسمبر، قال فيه إنه يفضل الاستقالة على القبول بمرشح يرفضه المحتجون.
ومع إصرار الرئيس، مسنودًا بموقف الحركة الاحتجاجية ومرجعية النجف، على رفض مرشحين
ففي الأول من شباط/ فبراير 2020 كلف رئيس الجمهورية الوزير السابق، محمد توفيق علاوي، بتشكيل الحكومة، لكن الرجل اضطر إلى الانسحاب في الأول من آذار/ مارس، بعد أن فشل البرلمان على مدى يومين في تحقيق النصاب اللازم لمنحه الثقة، كما قدّم الطرفان، الكردي والسني، اعتراضًا جوهريًا على صيغة الحكومة، لأنها لم تتضمن حصصهم الحزبية.
وفي 17 آذار/ مارس كلف رئيس الجمهورية النائب عدنان الزرفي، وهو محافظ النجف السابق الذي يرتبط بعلاقة قوية مع واشنطن، ويدعم منظماتٍ شبابية تناوئ الأحزاب الدينية. وقد مثل ترشيحه تحدّيًا كبيرًا لمعظم القوى السياسية الشيعية التي وجدت أنّ "حقها" في ترشيح رئيس الحكومة يصادره رئيس الجمهورية. أما القوى السياسية الكردية والسنية فقد التزمت الحياد، معتبرة أن مسؤولية تسمية رئيس الحكومة تعتمد على توافق ما يسمى "البيت الشيعي"، وهو ما أدّى إلى انسحاب الزرفي، وتكليف الكاظمي في 9 نيسان/ أبريل 2020.
تغير في الموقف الإيراني
مثلت موافقة البرلمان على منح الثقة لحكومة الكاظمي مفاجأة لكثيرين، ذلك أن الكاظمي كان حتى قبل أيام من جلسة منح الثقة محل رفض شديد من حلفاء طهران، بل إن المليشيات الشيعية
ويرجع التغيير في موقف بعض القوى السياسية الشيعية من منح الثقة لحكومة الكاظمي (ظل ائتلاف دولة القانون برئاسة رئيس الحكومة الأسبق نوري المالكي على موقفه الرافض لها) إلى تغيير في موقف طهران التي فاجأها حجم الاحتجاجات الرافضة لتدخلها في شؤون العراق، خصوصا في مدن الوسط والجنوب ذات الغالبية الشيعية، حيث استهدف المحتجّون رموز إيران وحلفاءها في العراق، بما فيها قنصلياتها، في صعود لافت للشعور الوطني المُطالِب بعدم توريط العراق في أزمات دولية لصالح إيران.
وقد جاء ترشيح أسماء بعيدة عن طهران مؤشرًا على تحوّل كبير في قواعد اللعبة فرضته الحركة الاحتجاجية. وقد دفع ذلك قوى سياسية قريبة من إيران إلى إعادة حساباتها، مخافة أن تدفع الثمن في الانتخابات القادمة. أما إيران فما كان لها أن تستمر في رفض المرشحين إلى ما لا نهاية، بعد أن تحفظت على توفيق علاوي ورفضت عدنان الزرفي. وقُرئ ذلك أيضًا أنه إشارة إلى محاولات إيرانية للوصول إلى تسويةٍ تمكّن من مواصلة حكم العراق، أو للتهدئة مع واشنطن التي بدا أنها تقف بقوة وراء الكاظمي.
تشكيلة الحكومة
اختار الكاظمي في تشكيلة حكومته شخصياتٍ من داخل حركة الاحتجاج أو قريبة منها، وتعهد بتلبية مطالبها، على الرغم من عدم وضوح فرص نجاحه في ذلك، خصوصا بشأن الكشف عن قتلة المتظاهرين. ويبدو أن الكاظمي أراد من خلال ضمّ شخصيات في الحراك إلى حكومته أن يُقنع الكتل النيابية بأنّ الطريق الوحيد لإنقاذ النظام من الانهيار يتمثل في الاستجابة لمطالب الشارع. ولكن الخلافات بدت أعمق من مجرّد توزيع حقائب وزارية، ويتعلق الأمر خصوصًا بمخاوف إيران بشأن وضع حلفائها في العراق، والحصانة التي تريد أن تمنحها لهم، فضلًا عن مستقبل العلاقات بين بغداد وواشنطن، بينما يرفض الكاظمي تقديم تنازلاتٍ كبيرة. وقد تعزّز موقع الكاظمي، أخيرًا، بعد القرار الذي اتخذه المرجع علي السيستاني بفصل آلاف المقاتلين التابعين للمرجعية عن هيئة الحشد الشعبي وإلحاقهم بوزارة الدفاع. وقد شمل ذلك كتائب الإمام علي، وكتائب علي الأكبر، وفرقة العباس، ولواء أنصار المرجعية.
بعد مفاوضات صعبة، نجح الكاظمي في كسب الثقة لثلثَي وزرائه خلال جلسة استثنائية للبرلمان. لكن مرور الحكومة بشكلها الأخير تسبب في إحباطٍ في صفوف المحتجين، إذ اضطر الكاظمي إلى التضحية بعدد من مرشحيه الوزراء من أصحاب الخبرة والكفاءة المحسوبين على أجواء "انتفاضة أكتوبر". إلا أن خسارة الكاظمي في هذه الناحية يقابلها نجاحه في تعيين ضباط مستقلين عن نفوذ المليشيات الموالية لطهران، في مواقع وزارتَي الداخلية والدفاع، أضف إلى ذلك أن المخابرات وأركان الجيش وجهاز مكافحة الإرهاب، وهو جهاز كوماندوز عراقي مهم، بقيت تابعة عمليًا له. وقد اتخذ الكاظمي، عندما تسلَّم منصبه في رئاسة الحكومة، قرارًا بإعادة الفريق عبد الوهاب الساعدي إلى قيادة جهاز مكافحة الإرهاب، بعد أن أطاحه رئيس الحكومة السابق، عادل عبد المهدي، نتيجة شكاوى المليشيات القريبة من إيران.
تحدّيات تواجه الحكومة
تواجه حكومة الكاظمي تحدّيات كبرى ينبغي لها معالجتها، تتقدمها معالجة تداعيات وباء كورونا
سوف يحتاج الكاظمي أيضًا إلى إنشاء توازن في علاقته بطهران وواشنطن، حتى يضمن عدم عرقلة برامجه وسياسات حكومته. وستكون أولى خطواته في هذا الاتجاه إدارة الحوار الاستراتيجي بين واشنطن وبغداد المتوقع انطلاقه الصيف المقبل، حيث سيدرس الطرفان شكل الوجود العسكري الأميركي في العراق ومستويات التعاون، بعد أن فشلت طهران مع حلفائها في إجبار واشنطن على سحبٍ سريع للقوات، في إثر اغتيال سليماني. والأرجح أن يتمكّن الكاظمي من إنقاذ العراق من عزلة مالية ودبلوماسية كانت تحت الدراسة في واشنطن، في ظل اتهام رئيس الحكومة السابقة بأنه خضع أكثر مما ينبغي لنفوذ المليشيات الموالية لطهران.
يحظى الكاظمي في تحرّكه بدعم أطراف وازنة، مثل مرجعية النجف والتيارات والقوى العلمانية والكردية، غير أنّ فئاتٍ مؤثرة في أجواء حراك أكتوبر ترى أن النظام الحالي يعاني خللًا لا يمكن إصلاحه. ولكن، بدا خلال اليومين الأخيرين ميلٌ أكبر لدى المجاميع الشبابية الممثلة لحركة الاحتجاج إلى ضرورة منحه فرصة بوصفه الحل الوسط بين مطالب الحراك ومصالح الأحزاب والقوى المهيمنة على العملية السياسية منذ عام 2003، وأن ذلك قد يمثّل مدخلًا إلى تغييرٍ على مراحل، يكون أقل تكلفة من إسقاط النظام، وعلى أمل أن تؤدّي الانتخابات التي تعهّد الكاظمي بإجرائها إلى تغيير موازين القوى السياسية في العراق.