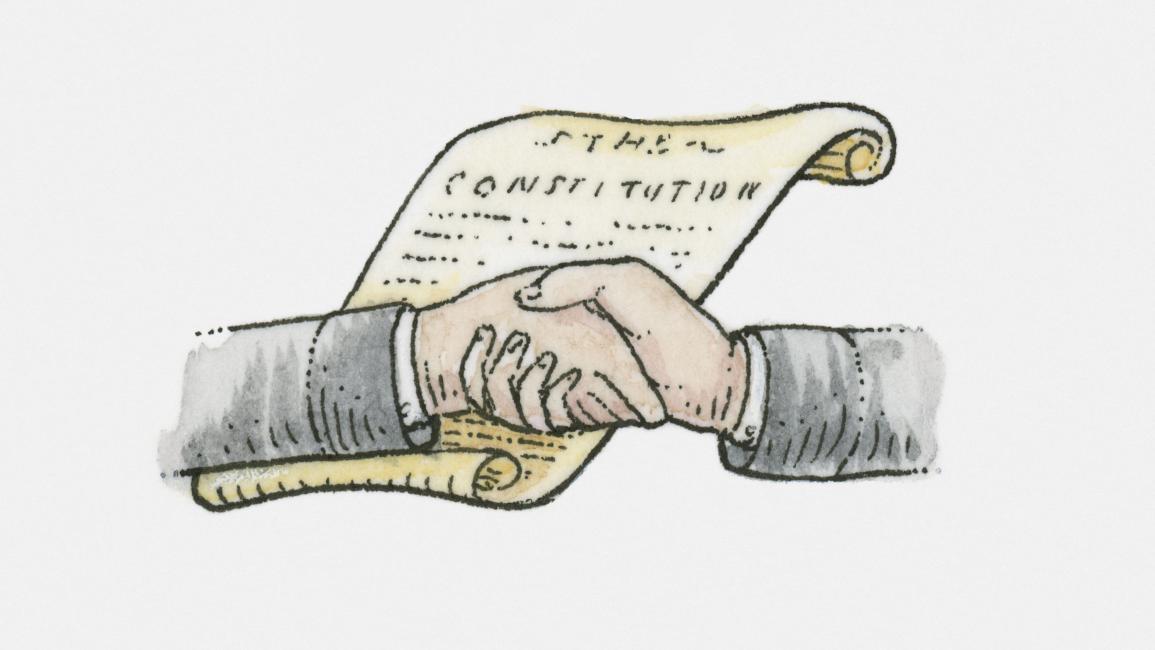19 أكتوبر 2019
المواطنة في زمن الربيع العربي
إذا كان هدف الأحزاب السياسية الوصول إلى الحكم، فإن هم المواطنة هو تقويم اعوجاج الحكام، ومراقبة تسيير الشأن العام. ومن هنا، من السهل على السلطة التلاعب بالأحزاب، إما بالاحتواء وشراء الذمم أو بالإقصاء والقمع، بشكل تصبح فيه جزءاً من النظام، كما حال المشهد السياسي العربي عموماً، حيث استنسخت الأنظمة نفسها بتحويل الأحزاب السائرة في فلكها، مثل المعارضة لها، إلى أنظمةٍ تسلطيةٍ مصغرة، يغيب عنها السلوك الديمقراطي مثل التناوب. لكن استراتيجية التعامل هذه لا تنفع مع المواطنة. وهذا ما يفسر، جزئياً، وجود التعددية الحزبية عربياً، فيما تغيب التعددية السياسية التي لا يمكنها أن تتطور في بيئة لا مواطنة فيها.
هناك فرق جوهري بين رفض أحزاب نظاماً ما ورفض مواطنين له. ففي الحالة الأولى، يكون الرفض فعل أقلية عددياً، وتشوبه شكوك، كون أي حزب هدفه الحكم. وبالتالي، قد يكون الرفض مطية لتحقيقه لا غير. كما أن هناك أحزاباً تغيرت مواقفها تماماً، بمجرد إشراكها في الحكومة، أو منحها امتيازات. أما الرفض المواطني فيكون جماعياً، ومتعدد ومختلف الأطياف والفئات، وغير مؤطر في الغالب، ما يُصعِّب من عملية الاستهداف الانتقائية، لإجهاض الحركة الاحتجاجية المواطنية. ومن هنا، فهو يطعن في شرعية النظام القائم. وبحكم ثقله العددي، لا يمكن أن يُختزل في عناصر مشاغبة، أو مخربة، أو حتى إرهابية، كما اعتادت الأنظمة الحاكمة على وسم كل حركة احتجاجية، ولا يمكن أن يُسجن، فالشعب يُستعبد، ويُقمع، ويُقهر، لكنه لا يُسجن كله. وهنا الفرق الجوهري بين تحرك أحزابٍ سياسيةٍ، تجد تجلياتها في مجموعة أفراد وتحرك شعبي واسع النطاق. وعليه، فالمواطنة أخطر من التحزب.
وأثبتت الحركات الاجتماعية في الغرب أن التعامل مع تحرك مواطني في غاية من الصعوبة، لأنه يأتي عفوياً وجماعياً، ويجمع مواطنين من مختلف الشرائح الاجتماعية والتوجهات السياسية، همهم المشترك الحفاظ على حقوقهم، ومستوى معيشتهم وحريتهم. والظروف التي سمحت بمثل هذه الظاهرة هي الوعي بالذات، وثقافة المساءلة والنقد والاختلاف في الرأي. طبعاً الأنظمة الديمقراطية هي التي سمحت بوجود مثل هذه الحركات، لكن الأخيرة قامت دفاعاً عن الديمقراطية والحرية، وليس ضدهما. وبما أنه لا خلط في الديار الغربية بين النظام (الديمقراطي) والحكومة، فإن العملية تحصيل حاصل. أما الأنظمة التسلطية، فتعرقل بناء المواطنة، خوفاً من المساءلة وحرية الرأي والحق في الاختلاف. يفسر هذا التخوف من المواطنة، والتي اختزلت في شقها القانوني المبتور أصلاً، تشدد القوانين العربية الخاصة بإنشاء الجمعيات الأهلية، إذ يبدو، أحياناً، تأسيس حزب سياسي أقل صعوبة من تأسيس جمعية.
لكن، هل من جديد مع الربيع العربي الذي هو أقوى تعبير عن المواطنة في تاريخ العرب المعاصر؟ عرفت الديمقراطيات الغربية، كما سبق التنويه، حركات اجتماعية وضعت المواطن في قلب الشأن العام، وهي حركات مواطنية بامتياز، لكن، شتان بين الوضع في الديار الغربية الديمقراطية والديار العربية التسلطية. ففي الأولى، المواطنة قائمة، وراسخة وما يحدث هو سعي المواطنين لتدعيمها، والدفاع عن المكاسب الاجتماعية والسياسية. أما في الثانية، فإن ما يحدث يعبر عن مواطنة ناشئة. والمشكلة أن هذه النشأة تواجه معوقات سياسية، لأن الأنظمة الحاكمة تعي جيداً أن ميلاد مواطنة غير مشوهة يعني وضع شرعيتها على المحك، واعتبارها المشكلة، وليس جزءاً من الحل، خصوصاً وأن لسان حال هذه الأنظمة هو: نداء البقاء في السلطة أقوى من نداء بناء الدولة والمواطنة.
طبعاً، يعني نشوء مواطنة خارج دائرة نفوذ الحكام وتلاعبهم مواطنة حرة. لكن المواطنة قيد التشكل في دول الربيع العربي لا تستفيد، إلى حد الآن، من دعم الدولة التي اختزلت واقترنت بالنظام البائد، وبالتالي، هي الأخرى قيد التشكل الحقيقي. ومن ثم، تجد المواطنة الناشئة نفسها في مواجهة تيارات وتنظيمات- دون الدولة– تسعى إلى فرض وصايتها على الشعب، وفرض تصورها لمستقبله، فضلاً عن إجهاض الأنظمة مشروع بناء المواطنة. كما أن المواطن الحالي، وهو أيضاً نتاج تراكمات تسلطية، ليس على درجة من الوعي، والروح النقدية وقبول الرأي المخالف، تسمح له بالتعامل مع الفكر الواحد (ثقافة الحزب الواحد السائدة، لأن التعددية حزبية، وليست سياسية). ثم إن هذه الإشكالية تجسد إشكالية أخرى، هي غياب المساواة بين الرجل والمرأة. إذ هناك سعي إلى تجديد وتحديث مقولات وممارسات سادت وما زالت. والحقيقة أنه لا مواطنة في سياق سياسي-اجتماعي لا يقر بالمساواة بين الجنسين. وعليه، فإن الراهن العربي الذي تميزه مواطنة ناشئة مرشح ليعرف توترات سياسية واجتماعية، بل ومواجهات بين التوجهات الدينية، لا سيما المتشددة والسلفية منها، والسياسية المحافظة من جهة، والتوجهات الليبرالية والتحديثية. وهذا طبيعي، إلا أن هذه "المواجهة" لا تتم في بيئة محايدة – تعلق الأمر بدول الانتقال، أو التسلطية – ذلك أن تراكمات الموروث التسلطي جعلت ثقافة تقبل الخطاب الديني عموماً (بغض النظر عن مصدره: سلطوي، إسلامي، سلفي...) و"الزعامة التسلطية" (بدعوى الاستقرار وغيره من المسوِّغات) عالية للغاية، وأبقت على سقف التسامح المدني منخفضاً للغاية.
وربما من بين دلالات المواطنة في خضم الربيع العربي تنامي تعبيرات المواطنة عبر شبكات التواصل الاجتماعية، وهي أبرز أدوات الفواعل الاجتماعية الصاعدة. ويشكل هذا الوضع الجديد هاجساً للأنظمة، حيث تتصاعد ظاهرة اعتقال مدونين اجتماعيين وسجنهم، فيما تراجعت بل واختفت ظاهرة اعتقال وسجن قيادات حزبية (باستثناء الحالة المصرية – الانقلابية – التي تمزج بين الظاهرتين). وهذا دلالة على ترويض للمعارضة، وسعي إلى ترويض المواطنة الناشئة (عبر الشبكات الاجتماعية).
هناك فرق جوهري بين رفض أحزاب نظاماً ما ورفض مواطنين له. ففي الحالة الأولى، يكون الرفض فعل أقلية عددياً، وتشوبه شكوك، كون أي حزب هدفه الحكم. وبالتالي، قد يكون الرفض مطية لتحقيقه لا غير. كما أن هناك أحزاباً تغيرت مواقفها تماماً، بمجرد إشراكها في الحكومة، أو منحها امتيازات. أما الرفض المواطني فيكون جماعياً، ومتعدد ومختلف الأطياف والفئات، وغير مؤطر في الغالب، ما يُصعِّب من عملية الاستهداف الانتقائية، لإجهاض الحركة الاحتجاجية المواطنية. ومن هنا، فهو يطعن في شرعية النظام القائم. وبحكم ثقله العددي، لا يمكن أن يُختزل في عناصر مشاغبة، أو مخربة، أو حتى إرهابية، كما اعتادت الأنظمة الحاكمة على وسم كل حركة احتجاجية، ولا يمكن أن يُسجن، فالشعب يُستعبد، ويُقمع، ويُقهر، لكنه لا يُسجن كله. وهنا الفرق الجوهري بين تحرك أحزابٍ سياسيةٍ، تجد تجلياتها في مجموعة أفراد وتحرك شعبي واسع النطاق. وعليه، فالمواطنة أخطر من التحزب.
وأثبتت الحركات الاجتماعية في الغرب أن التعامل مع تحرك مواطني في غاية من الصعوبة، لأنه يأتي عفوياً وجماعياً، ويجمع مواطنين من مختلف الشرائح الاجتماعية والتوجهات السياسية، همهم المشترك الحفاظ على حقوقهم، ومستوى معيشتهم وحريتهم. والظروف التي سمحت بمثل هذه الظاهرة هي الوعي بالذات، وثقافة المساءلة والنقد والاختلاف في الرأي. طبعاً الأنظمة الديمقراطية هي التي سمحت بوجود مثل هذه الحركات، لكن الأخيرة قامت دفاعاً عن الديمقراطية والحرية، وليس ضدهما. وبما أنه لا خلط في الديار الغربية بين النظام (الديمقراطي) والحكومة، فإن العملية تحصيل حاصل. أما الأنظمة التسلطية، فتعرقل بناء المواطنة، خوفاً من المساءلة وحرية الرأي والحق في الاختلاف. يفسر هذا التخوف من المواطنة، والتي اختزلت في شقها القانوني المبتور أصلاً، تشدد القوانين العربية الخاصة بإنشاء الجمعيات الأهلية، إذ يبدو، أحياناً، تأسيس حزب سياسي أقل صعوبة من تأسيس جمعية.
لكن، هل من جديد مع الربيع العربي الذي هو أقوى تعبير عن المواطنة في تاريخ العرب المعاصر؟ عرفت الديمقراطيات الغربية، كما سبق التنويه، حركات اجتماعية وضعت المواطن في قلب الشأن العام، وهي حركات مواطنية بامتياز، لكن، شتان بين الوضع في الديار الغربية الديمقراطية والديار العربية التسلطية. ففي الأولى، المواطنة قائمة، وراسخة وما يحدث هو سعي المواطنين لتدعيمها، والدفاع عن المكاسب الاجتماعية والسياسية. أما في الثانية، فإن ما يحدث يعبر عن مواطنة ناشئة. والمشكلة أن هذه النشأة تواجه معوقات سياسية، لأن الأنظمة الحاكمة تعي جيداً أن ميلاد مواطنة غير مشوهة يعني وضع شرعيتها على المحك، واعتبارها المشكلة، وليس جزءاً من الحل، خصوصاً وأن لسان حال هذه الأنظمة هو: نداء البقاء في السلطة أقوى من نداء بناء الدولة والمواطنة.
طبعاً، يعني نشوء مواطنة خارج دائرة نفوذ الحكام وتلاعبهم مواطنة حرة. لكن المواطنة قيد التشكل في دول الربيع العربي لا تستفيد، إلى حد الآن، من دعم الدولة التي اختزلت واقترنت بالنظام البائد، وبالتالي، هي الأخرى قيد التشكل الحقيقي. ومن ثم، تجد المواطنة الناشئة نفسها في مواجهة تيارات وتنظيمات- دون الدولة– تسعى إلى فرض وصايتها على الشعب، وفرض تصورها لمستقبله، فضلاً عن إجهاض الأنظمة مشروع بناء المواطنة. كما أن المواطن الحالي، وهو أيضاً نتاج تراكمات تسلطية، ليس على درجة من الوعي، والروح النقدية وقبول الرأي المخالف، تسمح له بالتعامل مع الفكر الواحد (ثقافة الحزب الواحد السائدة، لأن التعددية حزبية، وليست سياسية). ثم إن هذه الإشكالية تجسد إشكالية أخرى، هي غياب المساواة بين الرجل والمرأة. إذ هناك سعي إلى تجديد وتحديث مقولات وممارسات سادت وما زالت. والحقيقة أنه لا مواطنة في سياق سياسي-اجتماعي لا يقر بالمساواة بين الجنسين. وعليه، فإن الراهن العربي الذي تميزه مواطنة ناشئة مرشح ليعرف توترات سياسية واجتماعية، بل ومواجهات بين التوجهات الدينية، لا سيما المتشددة والسلفية منها، والسياسية المحافظة من جهة، والتوجهات الليبرالية والتحديثية. وهذا طبيعي، إلا أن هذه "المواجهة" لا تتم في بيئة محايدة – تعلق الأمر بدول الانتقال، أو التسلطية – ذلك أن تراكمات الموروث التسلطي جعلت ثقافة تقبل الخطاب الديني عموماً (بغض النظر عن مصدره: سلطوي، إسلامي، سلفي...) و"الزعامة التسلطية" (بدعوى الاستقرار وغيره من المسوِّغات) عالية للغاية، وأبقت على سقف التسامح المدني منخفضاً للغاية.
وربما من بين دلالات المواطنة في خضم الربيع العربي تنامي تعبيرات المواطنة عبر شبكات التواصل الاجتماعية، وهي أبرز أدوات الفواعل الاجتماعية الصاعدة. ويشكل هذا الوضع الجديد هاجساً للأنظمة، حيث تتصاعد ظاهرة اعتقال مدونين اجتماعيين وسجنهم، فيما تراجعت بل واختفت ظاهرة اعتقال وسجن قيادات حزبية (باستثناء الحالة المصرية – الانقلابية – التي تمزج بين الظاهرتين). وهذا دلالة على ترويض للمعارضة، وسعي إلى ترويض المواطنة الناشئة (عبر الشبكات الاجتماعية).