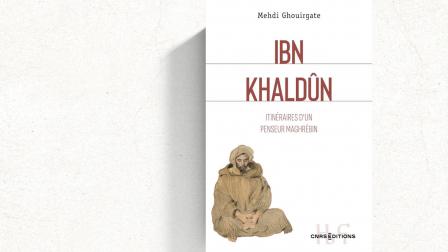نبيل عيوش أحد أهم المخرجين المغاربة (Getty)
يتميز الإنتاج السينمائي المغربي في السنوات الأخيرة بوفرة كمية تثير الانتباه. ويبقى هذا الإنتاج في حاجة إلى قراءة نقدية تدعمه بالتقيم وتساهم في إنعاشه بواسطه الغربلة والترتيب. إن المخرج المغربي في حاجة ماسة إلى رؤية صورته منعكسة على مرآة النقد، حتى يتسنى له تطوير أعماله وتجديد أدوات الوعي والكتابة. ومساهمة منا في هذا المشروع الفني والثقافي سنقوم بقراءة مكثفة للمنجز الفيلمي للسنوات الأخيرة التي برزت فيها أسماء طبعت السينما المغربية بميسمها وأسلوبها المتميّز.
اعتمدنا في قراءتنا لهذا المنجز الفيلمي على نظرية السينما واللاسينما التي طورها الباحث الفرنسي بيير مايو في كتابه "الكتابة السينمائية "، والتي استقاها من تنظيرالمخرج الفرنسي روبير بروسون، الذي لخصه في نظريته المعروفة "بالسينماتوغرافيا". وقد استفدنا كذلك من نباهة جان لوك كودار الذي لخص السؤال الأساسي للتمييز بين السينما واللاسينما من خلال قولته المعروفة "عندما تصور المرئي فأنت تنتج فيلما تلفزيونيا، وعندما تصور اللامرئي فأنت تصور فيلما سينمائيا". ولتوضيح الفرق بين المرئي واللامرئي ندعم منهجنا بنظرية الباحث الجمالي جورج ديدي هوبرمان الذي جسد نظرية المرئي واللامرئي من خلال إشارته إلى العلاقة الأيقونية بين العذراء والطفل واليمامة في اللوحات التشكيلية، والتي توحي بوجود الروح القدسي.
ولتطبيق هذه النظرية اعتمدت على ثلاثة إجراءات عملية تمكننا من ترتيب الفيلم المغربي عبر سلم ثلاثي حسب اقترابه أو ابتعاده من السينما ككتابة. ونلخص هذه الإجراءات في ثلاثة مفاهيم هي: العرض والحكي وإنتاج المعنى. إن المتأمل لهذه الأدوات سيلاحظ أنها تمثل الفعل السينمائي في كليته، بحيث إن الفيلم يعرض العالم من خلال تصويره، ثم يستعمل هذا العرض كأداة لحكاية قصة، وقد يدفع بهذا الإنجاز كله إلى إنتاج المعنى.
مستوى العرض: تساعدنا هذه الرؤية على القبض على مفهوم السينما المغربية بين الأرتيزانا والفن، كما تساعدنا على الحسم في الفرق بين السينما واللاسينما، خصوصا إذا كنا نؤمن أن ليس كل فيلم سينما، باعتبار أن الفيلم هو سلسلة متتالية من الصور. فأفلام سعيد الناصري ومحمد فريطس وعبدالله توكونة (فركوس) وفيلم تاونزا ويما وزينب وساكا وخارج التغطية والفردي وحياة الآخرين ورقصة الوحش واللائحة طويلة. هي أفلام وليست سينما. ومنها من حقق مداخيل مهمة ولقي إقبالا عند جمهور واسع. يقول بيير بورديو في هذا "إن قيمة العمل الفني لم تعد تأتي من الفنان ولكنها أصبحت تأتي، وبشكل مفروض، من السوق ومن الحقل
هذا ما جعل المخرجين أمثال حكيم نوري ومحمد إسماعيل وحسن بن جلون وأحمد بولان في أفلامهم الأولى يدخلون في خانة المخرجين الجماهريين الذين يشبعون انتظارات الرأي العام الفرجوي.
وتعتمد رؤية العرض الفرجوي هذه بعض الأحداث الواقعية التي تصورها بشكل خارجي، وهو ما يجعل هذه الأحداث تبقى في حدود المرئي ومحاولة الإيهام بالواقعي. وبهذا تبني قوة الإقناع على القصة الواقعية "أو قصة وقعت بالفعل"، وتتناسى "القصة الحقيقية"؛ أي القصة التي تبنيها السينماتوغرافيا وهي تتكلف بالمحكي الفيلمي الذي يظل غائباً لانعدام الوعي به. إذن نكون هنا أمام "الدرجة الصفر" من الوعي بالكتابة (ليس بالمعنى البارتي) التي تحوّل المرئي إلى بصري، إننا أمام "الرؤية الطبيعية" التي تظن أن إظهار حركية الواقع و"إعادة إنتاج" هذا الواقع أي الصور - الأشياء والصور - الأشخاص كافية لخلق حركة سينماتوغرافية تنتج المحكي بموضوعية ميكانيكية تبين وتعرض ولا تخفي شيئاً. وقد غيبت هذه المجموعة نظرية زفاتيني المعروفة التي تقول "إن الكتابة الحقيقية في السينما ليست هي اختراع قصص تشبه الواقع، إنما الكتابة الحقيقية هي النجاح في حكي الواقع وكأنه قصة"، والمقصود هنا بالقصة هو فن الحكي بالصورة أي بالسينماتوغرافيا.
مستوى الحكي
يتعدّد دور المخرج في هذا المستوى، فهو مطالب بتسلية الناس وإمتاعهم وإثارة عواطفهم، وربح المال من وراء إنتاجه والمساهمة في إثارة نقاش اجتماعي من خلال أفلامه. وتستمد هذه الأفلام قوتها من الحكاية، القصة، الحدوتة، لأنها تعطي القيمة للحدث، للفعل، وليس للصورة. فهي بالتالي تنتمي إلى المجال الإثيكي والسياسي، أثر منها إلى المجال الإستثيقي الجمالي.
تشتغل هذه الرؤية على محاولة البحث عن التوازن بين تشخيص الواقعي البروفيلمي والوساطة الإستثيقية للفيلمي، بمعنى السعي إلى تحقيق الواقعي من خلال ذكاء الإنجاز التقني والفني أو من خلال حقيقة الحياة كما هي.
ورغم أن أفلام هذه الرؤية تبني واقعاً تخييلياً مختلفاً عن الواقع الواقعي فإنها على وعي بأن إدراك المتلقي للفيلم لا يختلف عن إدراكه للواقع، لهذا يشتغل هؤلاء المخرجون على المواجهة بين الصورة - العرض والصورة - التشخيص، وفي هذا الإطار استطاع فيلم "البحث عن زوج امراتي" لمحمد عبد الرحمان التازي "وحب في الدار البيضاء" لعبد القادر لقطع و"علي زاوا" لنبيل عيوش "والملائكة لا تحلق فوق الدار البيضاء" أن يحقق التصالح بين الجمهور المغربي والسينما المغربية.
إن التمكن من "استثيقا غزل الحكاية"، وتدبير المحكي الفيلمي من خلال هندسة معمارية كامنة في اللا شعور البصري للمشاهد، أعطى للمخرج ضمانات قوية لغواية الجمهور ودفعه لمشاهدة هذه الأفلام. لقد استطاع هذا الاتجاه أن ينجح في إنتاج الفيلم الاجتماعي وأصبحت مصلحة هؤلاء المخرجين هي العمل على الاستمرار في إنتاج مثل هذه الأفلام، غير أن المصلحتين معاً؛ مصلحة المخرج ومصلحة الجمهور، غير كافيتين لتأسيس "فن السينما"، لأن ما ينقص في هذه الوضعية هو الإيمان والاعتقاد بهذا الفن.
مستوى إنتاج المعنى
إذا كان التيار الثاني يتجه نحو خلق "اسثتيقا غزل الحكاية" حسب زفاتيني، وحسب مفهوم شهرزاد التي حررت نفسها بواسطة الحكي، فإن اهتمام هذا التيار الثالث سيتجه نحو "استثيقا بناء الحكاية" حسب مفهوم أريستراكو، حيث سيصبح الحكي مجرد ذريعة، لأن البناء الشعري سينزع الصور من جمودها المرجعي؛ أي الصورة الحركية الحسية، لحفر ونحت المرئي وقتل مقروئيته البدئية، لبناء أو إعادة بناء التناقض الفاعل والفعال بين المعرفية المرجعية والرؤية البصرية السينمائية، التي تولد وتوحي باللا مرئي. وقد استطاع هذا التيار أن ينتقل بالسينما المغربية من منظومة السينما الكلاسيكية التي تعتمد مفهوم السينما - الحركة إلى منظور السينما الحديثة التي تعتمد مفهوم الصورة - الزمن التي تهدف إلى تحرير المرئي وإنقاده من الواقعي وتجديد النظر والرؤية والذوق، والخروج من جمود الكليشي إلى الرؤية التأملية لجوهر الأشياء وكنهها .
إن الباحث في أعمال هذه الجماعة يستنتج أنهم على وعي بأن السينما ليست فنا في حد ذاتها، فكما أن الكلمات والألوان والنوتات ليست فناً إلا أن الطريقة التي نستعملها بها هي التي تجعل من الكتابة فناً والتشكيل فناً والموسيقى فناً، فإن الصورة كذلك ليست فناً. إن العلامة السينماتوغرافية عندهم هي تشخيص وتمثيل، ولا يمكن أن تصل إلى الدلالة وإنتاج المعنى إلا عندما يتحول هذا التمثيل إلى مشاريع دلالية محتملة. لأن السياقية الشعرية تجعل الشيء المشخص يتورط في خلق الحدث وإنتاج المعنى، ليس فقط من خلال وجوده، ولكن من خلال جوهره وبعده الاستثيقي الشفاف واللماح للما وراء. إن السينما عندهم تبدأ ما وراء التماثل.
إن أفلام حكيم بلعباس وأفلام إسماعيل فروخي وفوزي بنسعيدي وبعض أفلام الجيلالي فرحاتي وفيلم الراكد لياسمين قصاري كلها علامات مضيئة تحاول جادة الانتقال من السينما الاجتماعية "المشكل والحل"، التي ينتجها التصور الثاني بامتياز، إلى سينما الإشكالية الاجتماعية التي تطرح أسئلة جذرية وشجاعة حول وجود الإنسان الفرد ووضعيته في عالمنا المعاصر، كما تبحث عن أسئلة وأجوبة غير يقينية تربط الحالة الإنسانية الخاصة بالتاريخ الاجتماعي.
إن هذه الجماعة استمرار لمشروع فني مكتمل لشاعر السينما المغربية ومبدعها أحمد البوعناني صاحب فيلم "السراب" الذي مات وفي نفسه شيء من السينما ومن اللامرئي.