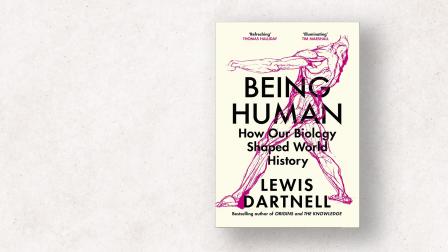غاية الثورة في أن "الحرية إزاء الاستبداد" (Getty)
عندما انفجرت في تونس الأحداث الثورية سنة 2011 بما استشرى عنها بعد ذلك في "الربيع العربي" تكشّفت المعضلة العربية بوجهيها: وجهٌ مشرق واعد عبّرت عنه أحداث المخاض التغييري بما فيه من تصميم وطاقات وآفاق ووجهٌ كالح تعرّت فيه الإعاقات والهنات بصورة مأساوية مكّنت لخيبة أمل واسعة وإحباطٍ مُهين.
كل ذلك انطلق من الشرارة التي أوقدها محمد البوعزيزي بجسده يوم 17 ديسمبر/كانون الأول 2010 احتجاجا على ما سُلّط عليه من تعسف وقهر. وإذا كان معظم النار من مستصغر الشرر فإن شرارة البوعزيزي استطاعت منذ اتقادها أن تتواصل هذه السنوات فتضيء أمام الجماهير وأمام الباحث المتأمل أكثر من قضية خطيرة وتدفع إلى استجلاء ما وقع استصغاره من أكبر الأسئلة.
ما أصدره محمد القوماني، الكاتب والحقوقي والمحلل السياسي التونسي، في دار ورقة للنشر هذا العام تحت عنوان "ما بعد العلمنة والأسلمة: مقاربات في الثورة والإسلام والحداثة" يتصل مباشرة بهذه القضايا الحارقة والمسكوت عنها. الكتاب بهذا المعنى حفرٌ في ما سماه المؤلف "سردية الثورة" وإرادةٌ للوعي بـ"الفُرَص المهدورة والمواطنة المتعثرة".
أول ما يوحي به الكتاب هو أن الثورة قضية مصيرية لما تطرحه من أسئلة كبرى. قبله عيّنت "حَنَّة أرنت" ARENDT Hannah غاية الثورة في أنها "الحرية إزاء الاستبداد" وأنها لذلك تلتقي مع الحرب لاشتراكهما في أنهما فعلٌ مؤسس للحرية. على ذلك فالثورة تتبدّى لحظاتٍ فارقة لانتفاضة عارمة تعبّر عن انفجار نظام اجتماعي قائم فَقَد مقومات الحياة وشرعية الوجود فتطايرت أجزاؤه دون أن يكون ذلك صنيع أحد. هي من هذا الجانب تكثيفٌ شديد للفاعلية الاجتماعية المركَّزة الناجمة عن إكراهات مُرّة وضغوط قاهرة ومظالم ومفاسد مستشرية ومدمرة.
ما ينفرد به كتاب محمد القوماني في تعاطيه مع الثورة مقارنة بما اشتغلت عليه المُنَظِّرة السياسية الألمانية فيما أَوْلته لمسألة العنف الجامع بين الثورة والحرب هو تنزيله للمسألة ضمن العُرف العربي- الإسلامي وما يقتضيه سياقه الحضاري الخاص اليوم. في هذا المستوى تكون القيمة الدلالية للثورة حسب "القوماني" في أنها سرديّة مغايرة لما ذهبت إليه"حنَّة أرندت" التي اعتبرت العنف، تمثلا للعرف التَوْراتي، هو البداية وأنه لا تأسيس للحرية من دون استخدامه. حين يستعمل الكتاب "سردية الثورة" فهو يركّز على أنها نظام يصوغ سلسلة الأحداث المتعددة بصورة تحمل على النظر والتحليل بتمثّل للثقافة الخاصة من خلال السياقات التي تتضمن كل ممكنات الفعل. هي بهذا المعنى صيرورةٌ ومنطقٌ ناظم لتعاقب الأحداث بما تضمره من إمكانات ثاوية.
في مستوى آخر، فإن ما تلا التشظي الهائل وما نجم عنه من صراع يُقدَّم في كتاب "ما بعد العلمنة والأسلمة" إعلانا على أن الثورة في تونس وخارجها هي إطاحة بمقولة الاستثناء العربي في خصوص القدرة على إقامة نظام سياسي تكون "المواطنة أساس الانتماء للدولة وقاعدة التعامل بين الحكّام والمحكومين وفي المجتمع".
اقــرأ أيضاً
بذلك تغدو إشكالية الكتاب متعلقة بالدلالة الصميمية للثورة التي تعني أساسا إمكانية قيام ثورات سلمية استثنائية يكون العنف طارئا عليها ومُسقطا إسقاطا. هي لذلك ترفض أن يكون العنف تأسيسا للحرية لأنه ليس سوى الوجه الآخر لمقولة الاستثناء بما يستبطنه من إقصاء وتَفرُّد وتنافٍ وإلغاء لقيم التعايش والتعدد.
بيت الداء فيما آلت إليه الأمور حسب "ما بعد العلمنة والأسلمة" هو التشبث بوهم التنافي الذي يخترق عموم النخب المفكرة والسياسية في ظن كل طرف امتلاكه للبديل الأمثل والأوحد. من هذا الوهم اندلع تنازع النخب وتدابرهم بعد الثورة. حصل ذلك بعد أن كانوا قد اكتووا بنيران الدكتاتوريات التي ألجأهم قهرُها إلى أن يتضامنوا ضدَّها. مع ذلك فقد استطاعوا في فترة قصيرة، رغم أنهم المستفيدون موضوعيا من الثورة، من أن ينشقُّوا عن بعضهم متصارعين بعنف وحديّة كان من الطبيعي أن يركبها أعداء الثورة في الداخل والخارج.
أخطر ما عَرَّته الثورات في انقسامات النخب العربية، خاصة بين العلمانيين والإسلاميين، هو امتدادها الذي شقّ كامل المجتمع بصورة مُرعبة ومؤدية في أكثر من حالة إلى حرب أهلية. حين يُغَنِّي أحدهم في مصر "إحنا شعب وهُمّا شعب، لينا رب وليهم رب" أو حين يُرفع في تونس شعار "تونس حرة حرة والإسلام على بَرَّه" ندرك أن الانقسام السياسي ذهب بعيدا إلى الأغوار. لقد انقضّ بقوةِ مقولةِ "العنف المؤسس" على الأعماق فصار الشرخ ثقافيا ومجتمعيا وأخلاقيا أي أنه تحوّل إلى فجيعة حرب طاحنة.
لهذا فإن كتاب محمد القوماني خصص من فصوله التسعة، ستةً لمعالجة هذا الاستقطاب في بعده الفكري والثقافي تصديّا لذات الوهم الذي يُهدِر فرصا تاريخية أتاحتها الثورات الناشئة من رحم شعوب متوثبة.
بهذا الاختيار يتبين مقصود الكاتب من العنوان الذي اختاره بجزئيه: "ما بعد العلمنة والأسلمة" و"مقاربات في الثورة والإسلام والحداثة". من جهة فإن الكتاب لا يرمي إلى دراسة أطروحتي العلمانية وأطروحة الإسلامية إنما هدفه تجاوزهما بنقيضهما الذي ينبغي إنشاؤه فكريا. ما أثبته الواقع هو أنهما كانتا مجرد نزعتين إيديولوجيتين تجسدتا في حركات وأحزاب تدّعي التعبير عن هذه الأطروحة أو تلك. ذلك أن الأمر بينهما لم يتجاوز منذ عقود حدّ التنازع الحدّي العقيم دون التمكّن من إقرار نظام علماني سليم يحترم كل معتقدات المواطنين أو الخروج عن دائرة ردود الأفعال بالاستجابة لمتطلبات المجتمع في بناء رؤية إسلامية معاصرة.
مؤدى هذا يوصل إلى التوليف المتعيّن في الجزء الثاني من عنوان الكتاب وهو الذي ينبغي أن تحققه الثورة في ضرورة البناء بين الإسلام والحداثة وإمكانية ذلك.
منهجيا، الكاتب لا يريد تقديم قراءة نقدية للأطروحتين بقدر انشغاله بمواقع الاشتباك والتوقف بينهما للوصول إلى حلول عملية. تلك هي توليفة الكتاب التي يمكن تلخيصها في أولوية الجمع بين القراءة في الثورة وبين المراجعات والاجتهادات في القضايا الخلافية وأن ذلك هو المَعْبَر الذي يتجاوز الثنائية العقيمة وما يثوي وراءها من تنافٍ مركزه وهم امتلاك الحقيقة.
هذا ما يسوّغ لمحمد القوماني أن يعالج في فصول ستة جملةً من المسائل مما كان يُعرف في التراث الإسلامي بجليل الكلام ودقيقه. عالج أولا مسألة الوحي وعلاقة القرآن بالعقل واهتم ثانيا بالتوحيد بصفته خاصية للإدراك والسلوك وتوقف ثالثا عند المساواة بين الرجال والنساء والحاجة إلى تطوير التشريعات الخاصة بهما وناقش رابعا طبيعة الانتقال من مقولة الخلافة الراشدة إلى النظام الجمهوري الديمقراطي، وركّز خامسا على التيار الاعتزالي وصياغته لفكر سياسي بلَبوسٍ ديني لينتهي سادسا إلى معنى العبادة وأهميتها في البناء المُرتقي بالذات وبالانتظام الاجتماعي.
تتضح أهمية هذه الفصول "الفكرية والعقدية" فيما اختاره الكاتب ليُنهي عليه عمله. في الفصلين الختاميين كان تقييمه النقدي موجَّها في الأول إلى مفارقة حركات الإسلام السياسي التي تُبدي تطورا سياسيا، شأن حركة النهضة في تونس، لكنها "تتردد" فكريا مراوِحَةً في سياق تقليدي يتمنّع عن كل مراجعة جادّة خارج الأنساق المغلقة. أما الفصل الختامي فكان مباشرةَ ما اعتبره القوماني شرطَ "النجاح في دخول عصر سياسي جديد" بالشروع في المراجعات الفكرية والتصورية. ذلك هو طوق النجاة الحاجز عن ابتذال الصراعات السياسيوية والتي تقتضي من عموم تيار الهوية، عروبيين وإسلاميين، أن يغادروا المواقع الدفاعية إلى متطلبات البناء. بهذا الرهان المتجاوز لخطاب التنافي ووهم "العنف المؤسس" القابع فيه يكون الفكر المجدد إسهاما في خطاب إنساني مفتوح قادر على إثراء الثقافة الكونية.
(كاتب وأكاديمي تونسي)
اقــرأ أيضاً
كل ذلك انطلق من الشرارة التي أوقدها محمد البوعزيزي بجسده يوم 17 ديسمبر/كانون الأول 2010 احتجاجا على ما سُلّط عليه من تعسف وقهر. وإذا كان معظم النار من مستصغر الشرر فإن شرارة البوعزيزي استطاعت منذ اتقادها أن تتواصل هذه السنوات فتضيء أمام الجماهير وأمام الباحث المتأمل أكثر من قضية خطيرة وتدفع إلى استجلاء ما وقع استصغاره من أكبر الأسئلة.
ما أصدره محمد القوماني، الكاتب والحقوقي والمحلل السياسي التونسي، في دار ورقة للنشر هذا العام تحت عنوان "ما بعد العلمنة والأسلمة: مقاربات في الثورة والإسلام والحداثة" يتصل مباشرة بهذه القضايا الحارقة والمسكوت عنها. الكتاب بهذا المعنى حفرٌ في ما سماه المؤلف "سردية الثورة" وإرادةٌ للوعي بـ"الفُرَص المهدورة والمواطنة المتعثرة".
أول ما يوحي به الكتاب هو أن الثورة قضية مصيرية لما تطرحه من أسئلة كبرى. قبله عيّنت "حَنَّة أرنت" ARENDT Hannah غاية الثورة في أنها "الحرية إزاء الاستبداد" وأنها لذلك تلتقي مع الحرب لاشتراكهما في أنهما فعلٌ مؤسس للحرية. على ذلك فالثورة تتبدّى لحظاتٍ فارقة لانتفاضة عارمة تعبّر عن انفجار نظام اجتماعي قائم فَقَد مقومات الحياة وشرعية الوجود فتطايرت أجزاؤه دون أن يكون ذلك صنيع أحد. هي من هذا الجانب تكثيفٌ شديد للفاعلية الاجتماعية المركَّزة الناجمة عن إكراهات مُرّة وضغوط قاهرة ومظالم ومفاسد مستشرية ومدمرة.
ما ينفرد به كتاب محمد القوماني في تعاطيه مع الثورة مقارنة بما اشتغلت عليه المُنَظِّرة السياسية الألمانية فيما أَوْلته لمسألة العنف الجامع بين الثورة والحرب هو تنزيله للمسألة ضمن العُرف العربي- الإسلامي وما يقتضيه سياقه الحضاري الخاص اليوم. في هذا المستوى تكون القيمة الدلالية للثورة حسب "القوماني" في أنها سرديّة مغايرة لما ذهبت إليه"حنَّة أرندت" التي اعتبرت العنف، تمثلا للعرف التَوْراتي، هو البداية وأنه لا تأسيس للحرية من دون استخدامه. حين يستعمل الكتاب "سردية الثورة" فهو يركّز على أنها نظام يصوغ سلسلة الأحداث المتعددة بصورة تحمل على النظر والتحليل بتمثّل للثقافة الخاصة من خلال السياقات التي تتضمن كل ممكنات الفعل. هي بهذا المعنى صيرورةٌ ومنطقٌ ناظم لتعاقب الأحداث بما تضمره من إمكانات ثاوية.
في مستوى آخر، فإن ما تلا التشظي الهائل وما نجم عنه من صراع يُقدَّم في كتاب "ما بعد العلمنة والأسلمة" إعلانا على أن الثورة في تونس وخارجها هي إطاحة بمقولة الاستثناء العربي في خصوص القدرة على إقامة نظام سياسي تكون "المواطنة أساس الانتماء للدولة وقاعدة التعامل بين الحكّام والمحكومين وفي المجتمع".
بذلك تغدو إشكالية الكتاب متعلقة بالدلالة الصميمية للثورة التي تعني أساسا إمكانية قيام ثورات سلمية استثنائية يكون العنف طارئا عليها ومُسقطا إسقاطا. هي لذلك ترفض أن يكون العنف تأسيسا للحرية لأنه ليس سوى الوجه الآخر لمقولة الاستثناء بما يستبطنه من إقصاء وتَفرُّد وتنافٍ وإلغاء لقيم التعايش والتعدد.
بيت الداء فيما آلت إليه الأمور حسب "ما بعد العلمنة والأسلمة" هو التشبث بوهم التنافي الذي يخترق عموم النخب المفكرة والسياسية في ظن كل طرف امتلاكه للبديل الأمثل والأوحد. من هذا الوهم اندلع تنازع النخب وتدابرهم بعد الثورة. حصل ذلك بعد أن كانوا قد اكتووا بنيران الدكتاتوريات التي ألجأهم قهرُها إلى أن يتضامنوا ضدَّها. مع ذلك فقد استطاعوا في فترة قصيرة، رغم أنهم المستفيدون موضوعيا من الثورة، من أن ينشقُّوا عن بعضهم متصارعين بعنف وحديّة كان من الطبيعي أن يركبها أعداء الثورة في الداخل والخارج.
أخطر ما عَرَّته الثورات في انقسامات النخب العربية، خاصة بين العلمانيين والإسلاميين، هو امتدادها الذي شقّ كامل المجتمع بصورة مُرعبة ومؤدية في أكثر من حالة إلى حرب أهلية. حين يُغَنِّي أحدهم في مصر "إحنا شعب وهُمّا شعب، لينا رب وليهم رب" أو حين يُرفع في تونس شعار "تونس حرة حرة والإسلام على بَرَّه" ندرك أن الانقسام السياسي ذهب بعيدا إلى الأغوار. لقد انقضّ بقوةِ مقولةِ "العنف المؤسس" على الأعماق فصار الشرخ ثقافيا ومجتمعيا وأخلاقيا أي أنه تحوّل إلى فجيعة حرب طاحنة.
لهذا فإن كتاب محمد القوماني خصص من فصوله التسعة، ستةً لمعالجة هذا الاستقطاب في بعده الفكري والثقافي تصديّا لذات الوهم الذي يُهدِر فرصا تاريخية أتاحتها الثورات الناشئة من رحم شعوب متوثبة.
بهذا الاختيار يتبين مقصود الكاتب من العنوان الذي اختاره بجزئيه: "ما بعد العلمنة والأسلمة" و"مقاربات في الثورة والإسلام والحداثة". من جهة فإن الكتاب لا يرمي إلى دراسة أطروحتي العلمانية وأطروحة الإسلامية إنما هدفه تجاوزهما بنقيضهما الذي ينبغي إنشاؤه فكريا. ما أثبته الواقع هو أنهما كانتا مجرد نزعتين إيديولوجيتين تجسدتا في حركات وأحزاب تدّعي التعبير عن هذه الأطروحة أو تلك. ذلك أن الأمر بينهما لم يتجاوز منذ عقود حدّ التنازع الحدّي العقيم دون التمكّن من إقرار نظام علماني سليم يحترم كل معتقدات المواطنين أو الخروج عن دائرة ردود الأفعال بالاستجابة لمتطلبات المجتمع في بناء رؤية إسلامية معاصرة.
مؤدى هذا يوصل إلى التوليف المتعيّن في الجزء الثاني من عنوان الكتاب وهو الذي ينبغي أن تحققه الثورة في ضرورة البناء بين الإسلام والحداثة وإمكانية ذلك.
منهجيا، الكاتب لا يريد تقديم قراءة نقدية للأطروحتين بقدر انشغاله بمواقع الاشتباك والتوقف بينهما للوصول إلى حلول عملية. تلك هي توليفة الكتاب التي يمكن تلخيصها في أولوية الجمع بين القراءة في الثورة وبين المراجعات والاجتهادات في القضايا الخلافية وأن ذلك هو المَعْبَر الذي يتجاوز الثنائية العقيمة وما يثوي وراءها من تنافٍ مركزه وهم امتلاك الحقيقة.
هذا ما يسوّغ لمحمد القوماني أن يعالج في فصول ستة جملةً من المسائل مما كان يُعرف في التراث الإسلامي بجليل الكلام ودقيقه. عالج أولا مسألة الوحي وعلاقة القرآن بالعقل واهتم ثانيا بالتوحيد بصفته خاصية للإدراك والسلوك وتوقف ثالثا عند المساواة بين الرجال والنساء والحاجة إلى تطوير التشريعات الخاصة بهما وناقش رابعا طبيعة الانتقال من مقولة الخلافة الراشدة إلى النظام الجمهوري الديمقراطي، وركّز خامسا على التيار الاعتزالي وصياغته لفكر سياسي بلَبوسٍ ديني لينتهي سادسا إلى معنى العبادة وأهميتها في البناء المُرتقي بالذات وبالانتظام الاجتماعي.
تتضح أهمية هذه الفصول "الفكرية والعقدية" فيما اختاره الكاتب ليُنهي عليه عمله. في الفصلين الختاميين كان تقييمه النقدي موجَّها في الأول إلى مفارقة حركات الإسلام السياسي التي تُبدي تطورا سياسيا، شأن حركة النهضة في تونس، لكنها "تتردد" فكريا مراوِحَةً في سياق تقليدي يتمنّع عن كل مراجعة جادّة خارج الأنساق المغلقة. أما الفصل الختامي فكان مباشرةَ ما اعتبره القوماني شرطَ "النجاح في دخول عصر سياسي جديد" بالشروع في المراجعات الفكرية والتصورية. ذلك هو طوق النجاة الحاجز عن ابتذال الصراعات السياسيوية والتي تقتضي من عموم تيار الهوية، عروبيين وإسلاميين، أن يغادروا المواقع الدفاعية إلى متطلبات البناء. بهذا الرهان المتجاوز لخطاب التنافي ووهم "العنف المؤسس" القابع فيه يكون الفكر المجدد إسهاما في خطاب إنساني مفتوح قادر على إثراء الثقافة الكونية.
(كاتب وأكاديمي تونسي)