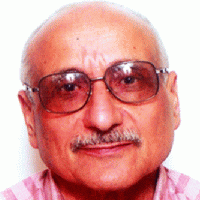العراق والصوت الغائب للمثقف
مهمة المثقف والكاتب أن يكشف الزيف (Getty)
لا أعرف معجزةً يمكن أن تحدث فجأة، لتعيد الصواب إلى شعبٍ، ليكف عن ممارسة هوايته في تدمير نفسه، إلى حد الفناء، لكنني أعرف شعوباً وأمماً انتهت، ليس إلى آخر رجل فحسب، ولكن، إلى آخر طفل، بفعل هوايتها الشريرة التي توارثتها عبر عقود من الذل، والحقد، والرغبة في الانتقام والثأر.
ثمّة بيانات، وأخبار عاجلة، تحتل الشاشات، لتصدع رؤوسنا، كل ساعة، عن قتلى، ومخنوقين، ومحروقين، ومذبوحين من الوريد إلى الوريد، وعن مخطوفين، ومغتصبين، ومكممي أفواه. ثمّة مليشيات، وعصابات، وجيوش، وطوائف، وعشائر، تتناسل يومياً، لتعبر عن "ديمقراطية" شريرة، زرعها، في هذا البلد، محتلون أوغاد، ليكرسوا واقعاً ظلامياً أسود، مصبوغاً بالدم. ثمّة أشباح، وشياطين، وتجار دين، وأدعياء سياسة، يلتقون تحت جنح الليل، يتحاورون، ويتذاكرون، ويتقاسمون الغنائم، ثم يختفون، مخلفين وراءهم الرماد، والطين، والعتمة، والدم المسفوح.
من يفعل ذلك سوانا نحن؟ وكيف تولدت لدينا هذه "السادية" المفرطة التي نمارسها علنا، وتحت أشعة الشمس، من دون أن يرف لنا جفن؟
لماذا يبلغ الواحد منا حد القطيعة مع مفردات العيش اليومية، البالغة البراءة، لماذا تتبلد مشاعرنا، إلى درجة فقدان الإحساس بمتعة شرب فنجان القهوة في المقهى البرازيلية التي كانت في شارع الرشيد، الأكثر شهرة في عالمنا العربي؟ لماذا نفتقد فرصة تأمل لوحة لفائق حسن، أو عطا صبري، أو رافع الناصري، أو ضياء العزاوي، أو ليلى العطار، أو سواهم من رواد التشكيل والإبداع في بلادنا؟ لماذا ينسى الواحد منا قصائد علي ابن الجهم، وعلي الجارم، والجواهري، وسعيد عقل، والسياب، ومصطفى جمال الدين، ومظفر النواب، وكل الذين تغنّوا ببغداد، وشربوا من دجلتها، وتغزلوا بحسناواتها؟ ثم لماذا نمارس القطيعة مع أغنيات فيروز، ومقامات ناظم الغزالي، ومواويل وديع الصافي، ونقيم المناحات في طول البلاد وعرضها، وعلى امتداد الفصول، وكأن حبيباتنا هجرننا، وتزوجن غيرنا؟
كيف تغيب، فجأة، "عيون المها بين الرصافة والجسر"، لتحل محلهن العيون الشريرة، المتشحة بالسواد، والحاملة خناجر الحقد والجريمة؟
ولماذا لا تجد "ليلى المريضة في العراق"، في أيامنا هذه، من يعشقها، ويحنو عليها، كما فعل معها زكي مبارك، وهي التي توارثت العشق، جيلاً بعد جيل، عن ليلى، ولبنى، وبلقيس، وسميراميس، وعشتار؟ لماذا نشرعن لأطفالنا ثقافة الموت، ونعلمهم كيف يضربون رؤوسهم بالقامات والسكاكين، ونورثهم جلد الذات، وكأنهم الذين قتلوا أئمتنا، وأولياءنا، ورجالنا الصالحين؟ لماذا أصبحت الدعوة إلى العروبة جريمة، فيما أصبحت الدعوة إلى الطائفة أو المذهب أو العشيرة أو سواها "قدس الأقداس"، لا يجوز المس بها، أو النيل منها؟
هل أصبح جرح بغداد عصياً على الالتئام، كما جروح القدس ودمشق وطرابلس، وسواها من جروح مدننا العربية التي أوشكت أن تتحول إلى قروح مستديمة، قد تفضي إلى الموت. من يدق جرس الإنذار لأبنائنا وأحفادنا الذين ليس لنا ما نورثهم إياه سوى عجزنا وغبائنا وخواء عقولنا؟
كم تبدو عصية على الفهم طاقة التدمير لدى هذا الشعب، وكم هي مثيرة للألم والشفقة ممارسة هذه الطاقة، كل يوم، وكل ساعة، وكيف يمكن أن نوقف ذلك كله من دون أن يخامرنا شعور بالمرارة والعجز؟
أية عقول خاوية نحملها في رؤوسنا تلك التي تدفعنا إلى إشعال النار في رفوف المكتبات، وتدمير آثار حضاراتنا الممتدة سبعة آلاف عام، وإغراق ساحاتنا بالدم. لماذا نرى ولاة أمورنا يظلموننا، ويقمعون أصواتنا، وينهبون ثرواتنا، ولا نستطيع أن نغيّر من أمرهم شيئاً، لا بأيدينا، ولا بألسنتنا، ولا حتى بقلوبنا، أليس ذلك إقراراً منا بالعجز، وقبولاً بالذل، وسكوتاً عن الحق؟
أيضاً، وأيضاً، كيف لنا أن نصمت، ونحن نختار، عن سابق وعي وتصميم، طريقنا الموصل إلى الهاوية؟ لماذا يصمت المثقف في بلادنا عن إدانة الماثل أمام عينيه، وهو يدرك جيداً أن المطلوب منه، في هذا الزمن، البالغ الرداءة والشديد القسوة، صوته، وليس صمته. وإذا لم تكن مهمة المثقف والكاتب أن يكشف الزيف، ويواجه الخنوع، ويبشر بثقافة الحياة، فما مهمته إذن؟