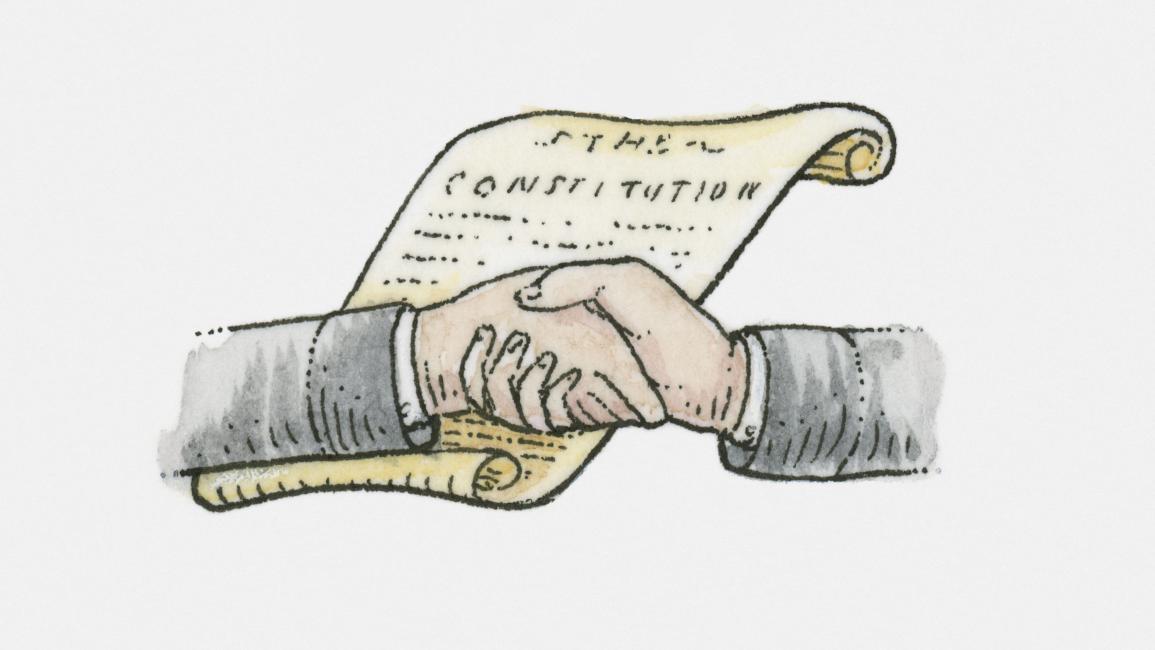01 فبراير 2019
الدولة المدنية .. منطق السياسة ومنطق الفكر
يعود الجدل من جديد بشأن الدولة المدنية، كأحد المفاهيم التي شكلت جزءاً من ارتداداتٍ فكريةٍ لموجة "الربيع العربي". وكان المفهوم سابقاً بعقود عن أحداث 2011، لكنه ما كان ليحظى بمثل هذا الانتشار والتداول والحضور العمومي، لولا سياق ما بعد الثورات. حضورٌ يبدو، في الواقع، موازياً موضوعياً لغياب مفهوم آخر عن التداول العام؛ وهو العلمانية. حيث لم يفض أزيد من قرنٍ على ولوج الفكرة العلمانية ساحة الفكر العربي، سوى إلى تكريس التباساتها الأيديولوجية، وعزلتها كاختيار سياسي. وإذا كانت جبهة الحداثة داخل خريطة التيارات الفكرية العربية المعاصرة لم تُجمع على تبنيها، كإحدى مقومات النهضة الممكنة، بدعوى انها فكرة مستوردة (برهان غليون)، أو أنها ليست مطابقةً للحاجة التاريخية العربية، مثل مطلبي الديمقراطية والعقلانية (محمد عابد الجابري)، فإن الرهان على مسار "علمنة موضوعية صامتة"، قادرة على فرض طابع "الزمنية" على الدولة الوطنية، قد تعرض، بدوره، لفشل ذريع.
هذا ما جعل الجهود الفكرية المنافحة عن مشروع العلمانية تعيش على إيقاع تصاعد التقليد والمحافظة والإسلام السياسي داخل المجتمعات العربية، سياق جعل العلمانية تصبح، بتعبير جورج طرابيشي، كلمة "رجيمة" في سوق التداول المفاهيمي العربي. وربما مثل هذا الوضع هو الذي قد يكون جعل التيارات التقدمية، داخل ساحات التغيير العربية، تشاطر التيارات الإسلامية شعار الدولة المدنية.
شعار يحفظ للعلمانيين دفاعهم عن مجال سياسي بشري، ووضعي، تسوده النسبية وشرعية الاقتراع العام، ويجنبهم صدامية الدعوة المباشرة للعلمانية، ويجسد خطوة مهمة في إطار مراجعات، وتكيف الفكر السياسي للحركات الإسلامية، مع متطلبات تدبير الشأن العام.
لذلك، يمكن قراءة مطلب الدولة المدنية على ضوء السياق السياسي، كمفهوم توافقي، تعزز في ظل ملابسات تقارب العلمانيين والإسلاميين داخل ساحات الربيع العربي. على أن الاختبار الأول لهذا التوافق كان هو لحظة كتابة دستور "أنظمة" ما بعد الربيع العربي، حيث برزت قضايا الهوية، وتوصيف الدولة في علاقتها بالدين، وموقع الشريعة في عملية صناعة القوانين، إحدى أسئلة "دستورنية" الربيع العربي.
وهنا، فإن التعاطي الدستوري مع هذه القضايا تغير بين حالات الهيمنة الايديولوجية والغلبة السياسية أو التسوية التوافقية. فلقد ارتبطت صياغة دستور الجمهورية الثانية، أو دستور الثورة المصرية، عام 2012، بسياقٍ لم يسمح بانتصار فكرة صنع الدستور، ضمن مقاربة استراتيجية ومجتمعية، إذ تم تغليب التدبير التكتيكي لما أسمته البلاغة، السائدة آنذاك، معركة الدستور.
ولعل هذا المنطق هو الذي ساعد، بالنسبة لبعض الباحثين، القوى المهيمنة، في مشهد ما بعد 25 يناير على التفاوض حول المكتسبات الظرفية التي تأمل تحقيقها من الدستور. هنا، انصب اهتمام القوى الإسلامية، خصوصاً التيار السلفي، على المواد الخاصة بمقومات الدولة والمجتمع، والتي اعتبرتها تمس هوية مصر. وقد أنتج هذا الحال دستوراً يُجسّد الهيمنة الأيديولوجية، ويُرسخ تجسيداً للوثيقة الدستورية المثقلة بالخطابات واللغة الأخلاقية والهواجس الهوياتية.
وبالعلاقة بميزان القوى السياسي الذي أنتج وثيقة الدستور المصري 2014، يمكن اعتبار الأخير محاولةً لتعطيل الإدعاءات الهوياتية التي جاء بها دستور 2012. فالمؤكد أن الطابع الجوهري للدستور المصري الثاني بعد الثورة، يبرز، أساساً، في إعادة النظر في المواد المتعلقة بالهوية، والتي جاء بها الدستور المعطل، بتأثير من الحالة السياسية، كما بعد ثورة 25 يناير، أو بضغط كبير من أنصار التيار السلفي. وهكذا، تم إلغاء الصياغة المثيرة للجدل التي تضمنها دستور 2012، والتي تشترط أن يُستشار الأزهر في المسائل المتعلقة بالشريعة الإسلامية. وقبل ذلك، سيتم تغيير صياغة الفصل الأول الذي عوض أن ينص على أن الشعب المصري جزء من الأمتين العربية والإسلامية، أصبح يُعرف الشعب المصري جزءاً من الأمة العربية يعمل على تكاملها ووحدتها، معتبراً أن مصر جزء من العالم (وليس الأمة) الإسلامي، تنتمي إلى القارة الإفريقية، وتعتز بامتدادها الآسيوي، وتسهم في بناء الحضارة الإنسانية. واختفى التنصيص الوارد في المادة السادسة من الدستور المعطل، والذي يتحدث عن الديموقراطية والشورى مقومتين للنظام السياسي.
هل مع كل التعديلات، يمكن اعتبار دستور 2014، دستوراً للدولة المدنية؟ ليس الجواب مؤكداً، فبعضهم يعتبر أن لجنة الخمسين، والتي يُفترض أنها ذات أغلبية مدنية، ضحّت بالدولة المدنية في مقابل تعديلاتٍ متوسطةٍ، لأهمية تناسب موقفها من التيار الإخواني، وإنها، في المقابل، لم تعمل سوى على دسترة "الدولة العميقة "، واضعة مفهوم الدولة المدنية نفسه كمقابل، هذه المرة، لحكم العسكر، موضع تشكيك.
وضمن منطقٍ بعيدٍ عن مقاربتي الهيمنة، أو الغلبة، تم تدبير الملف الدستوري في جوابه عن الأسئلة الملتهبة حول الهوية، ومآل الدولة المدنية، وعلاقة الشريعة الإسلامية بالقانون، في الحالة التونسية بكثير من روح التسوية والتوازن.
هكذا، زاوج الدستور التونسي، في توصيفه الدولة، بين اعتبارها دولة حرة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها، واعتبارها دولة مدنية، تقوم على المواطنة وإرادة الشعب وعلوية القانون.
الدولة المدنية، هنا، تعني، بمنطوق ديباجة هذا الدستور، الدولة، حيث الحكم للقانون والسيادة للشعب عبر التداول السلمي على الحكم، بواسطة الانتخابات الحرة، وعلى مبدأ الفصل بين السلطات والتوازن بينها. وسنجد التوازن نفسه في مقتضى آخر، يعتبر من جهة الدولة راعية للدين، ومن جهة أخرى كافلةً لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية، حامية للمقدسات، ضامنة حياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي.
أعادت، إذن، الثورات العربية ودساتيرها موضعة مفهوم "الدولة المدنية" شعاراً مرحلياً، يسمح بتوافق الاتجاهات الاساسية داخل كل من الإسلاميين والعلمانيين، والواقع أن الطابع التكتيكي والسياسي لمضمون "الدولة المدنية" سيبرز قابليته الكبيرة للتأويل، خصوصاً من بعض تيارات الإسلام السياسي، والتي دافعت، مثلاً، عن تصور الشيخ يوسف القرضاوي الذي تحدث عن "الدولة المدنية بالمرجعية الإسلامية".
وهنا، فإن هشاشة المضمون السياسي الذي تم إعطاؤه لهذا المفهوم ترجع، في الوقت نفسه، لارتهانه بمعطيات السياق السياسي، خصوصاً مع مآلاتٍ غير سعيدة لوحدة "النضال الميداني" بين الإسلاميين والعلمانيين، في لحظة "الساحات العمومية". ما يجعل الأسئلة العميقة بشأن علاقة الدين بالسياسة، والحداثة السياسية والإصلاح الديني والمواطنة، تعود لتظهر من جديد، كاشفة الحدود التي يحملها مفهوم "الدولة المدنية " نفسه.
في نهاية التحليل، من المهم التأكيد على أن قابلية هذا المفهوم لتشكيل أرضيةٍ توافقيةٍ، سياسية/دستورية ممكنة بين الإسلاميين والعلمانيين، لا يجب أن تلغي، بعيداً عن منطق التسويات، الحاجة الفكرية لتجديد واستمرار الترافع من أجل العلمانية، أفقاً تاريخياً لمصالحة العرب مع الحداثة.
هذا ما جعل الجهود الفكرية المنافحة عن مشروع العلمانية تعيش على إيقاع تصاعد التقليد والمحافظة والإسلام السياسي داخل المجتمعات العربية، سياق جعل العلمانية تصبح، بتعبير جورج طرابيشي، كلمة "رجيمة" في سوق التداول المفاهيمي العربي. وربما مثل هذا الوضع هو الذي قد يكون جعل التيارات التقدمية، داخل ساحات التغيير العربية، تشاطر التيارات الإسلامية شعار الدولة المدنية.
شعار يحفظ للعلمانيين دفاعهم عن مجال سياسي بشري، ووضعي، تسوده النسبية وشرعية الاقتراع العام، ويجنبهم صدامية الدعوة المباشرة للعلمانية، ويجسد خطوة مهمة في إطار مراجعات، وتكيف الفكر السياسي للحركات الإسلامية، مع متطلبات تدبير الشأن العام.
لذلك، يمكن قراءة مطلب الدولة المدنية على ضوء السياق السياسي، كمفهوم توافقي، تعزز في ظل ملابسات تقارب العلمانيين والإسلاميين داخل ساحات الربيع العربي. على أن الاختبار الأول لهذا التوافق كان هو لحظة كتابة دستور "أنظمة" ما بعد الربيع العربي، حيث برزت قضايا الهوية، وتوصيف الدولة في علاقتها بالدين، وموقع الشريعة في عملية صناعة القوانين، إحدى أسئلة "دستورنية" الربيع العربي.
وهنا، فإن التعاطي الدستوري مع هذه القضايا تغير بين حالات الهيمنة الايديولوجية والغلبة السياسية أو التسوية التوافقية. فلقد ارتبطت صياغة دستور الجمهورية الثانية، أو دستور الثورة المصرية، عام 2012، بسياقٍ لم يسمح بانتصار فكرة صنع الدستور، ضمن مقاربة استراتيجية ومجتمعية، إذ تم تغليب التدبير التكتيكي لما أسمته البلاغة، السائدة آنذاك، معركة الدستور.
ولعل هذا المنطق هو الذي ساعد، بالنسبة لبعض الباحثين، القوى المهيمنة، في مشهد ما بعد 25 يناير على التفاوض حول المكتسبات الظرفية التي تأمل تحقيقها من الدستور. هنا، انصب اهتمام القوى الإسلامية، خصوصاً التيار السلفي، على المواد الخاصة بمقومات الدولة والمجتمع، والتي اعتبرتها تمس هوية مصر. وقد أنتج هذا الحال دستوراً يُجسّد الهيمنة الأيديولوجية، ويُرسخ تجسيداً للوثيقة الدستورية المثقلة بالخطابات واللغة الأخلاقية والهواجس الهوياتية.
وبالعلاقة بميزان القوى السياسي الذي أنتج وثيقة الدستور المصري 2014، يمكن اعتبار الأخير محاولةً لتعطيل الإدعاءات الهوياتية التي جاء بها دستور 2012. فالمؤكد أن الطابع الجوهري للدستور المصري الثاني بعد الثورة، يبرز، أساساً، في إعادة النظر في المواد المتعلقة بالهوية، والتي جاء بها الدستور المعطل، بتأثير من الحالة السياسية، كما بعد ثورة 25 يناير، أو بضغط كبير من أنصار التيار السلفي. وهكذا، تم إلغاء الصياغة المثيرة للجدل التي تضمنها دستور 2012، والتي تشترط أن يُستشار الأزهر في المسائل المتعلقة بالشريعة الإسلامية. وقبل ذلك، سيتم تغيير صياغة الفصل الأول الذي عوض أن ينص على أن الشعب المصري جزء من الأمتين العربية والإسلامية، أصبح يُعرف الشعب المصري جزءاً من الأمة العربية يعمل على تكاملها ووحدتها، معتبراً أن مصر جزء من العالم (وليس الأمة) الإسلامي، تنتمي إلى القارة الإفريقية، وتعتز بامتدادها الآسيوي، وتسهم في بناء الحضارة الإنسانية. واختفى التنصيص الوارد في المادة السادسة من الدستور المعطل، والذي يتحدث عن الديموقراطية والشورى مقومتين للنظام السياسي.
هل مع كل التعديلات، يمكن اعتبار دستور 2014، دستوراً للدولة المدنية؟ ليس الجواب مؤكداً، فبعضهم يعتبر أن لجنة الخمسين، والتي يُفترض أنها ذات أغلبية مدنية، ضحّت بالدولة المدنية في مقابل تعديلاتٍ متوسطةٍ، لأهمية تناسب موقفها من التيار الإخواني، وإنها، في المقابل، لم تعمل سوى على دسترة "الدولة العميقة "، واضعة مفهوم الدولة المدنية نفسه كمقابل، هذه المرة، لحكم العسكر، موضع تشكيك.
وضمن منطقٍ بعيدٍ عن مقاربتي الهيمنة، أو الغلبة، تم تدبير الملف الدستوري في جوابه عن الأسئلة الملتهبة حول الهوية، ومآل الدولة المدنية، وعلاقة الشريعة الإسلامية بالقانون، في الحالة التونسية بكثير من روح التسوية والتوازن.
هكذا، زاوج الدستور التونسي، في توصيفه الدولة، بين اعتبارها دولة حرة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها، واعتبارها دولة مدنية، تقوم على المواطنة وإرادة الشعب وعلوية القانون.
الدولة المدنية، هنا، تعني، بمنطوق ديباجة هذا الدستور، الدولة، حيث الحكم للقانون والسيادة للشعب عبر التداول السلمي على الحكم، بواسطة الانتخابات الحرة، وعلى مبدأ الفصل بين السلطات والتوازن بينها. وسنجد التوازن نفسه في مقتضى آخر، يعتبر من جهة الدولة راعية للدين، ومن جهة أخرى كافلةً لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية، حامية للمقدسات، ضامنة حياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي.
أعادت، إذن، الثورات العربية ودساتيرها موضعة مفهوم "الدولة المدنية" شعاراً مرحلياً، يسمح بتوافق الاتجاهات الاساسية داخل كل من الإسلاميين والعلمانيين، والواقع أن الطابع التكتيكي والسياسي لمضمون "الدولة المدنية" سيبرز قابليته الكبيرة للتأويل، خصوصاً من بعض تيارات الإسلام السياسي، والتي دافعت، مثلاً، عن تصور الشيخ يوسف القرضاوي الذي تحدث عن "الدولة المدنية بالمرجعية الإسلامية".
وهنا، فإن هشاشة المضمون السياسي الذي تم إعطاؤه لهذا المفهوم ترجع، في الوقت نفسه، لارتهانه بمعطيات السياق السياسي، خصوصاً مع مآلاتٍ غير سعيدة لوحدة "النضال الميداني" بين الإسلاميين والعلمانيين، في لحظة "الساحات العمومية". ما يجعل الأسئلة العميقة بشأن علاقة الدين بالسياسة، والحداثة السياسية والإصلاح الديني والمواطنة، تعود لتظهر من جديد، كاشفة الحدود التي يحملها مفهوم "الدولة المدنية " نفسه.
في نهاية التحليل، من المهم التأكيد على أن قابلية هذا المفهوم لتشكيل أرضيةٍ توافقيةٍ، سياسية/دستورية ممكنة بين الإسلاميين والعلمانيين، لا يجب أن تلغي، بعيداً عن منطق التسويات، الحاجة الفكرية لتجديد واستمرار الترافع من أجل العلمانية، أفقاً تاريخياً لمصالحة العرب مع الحداثة.