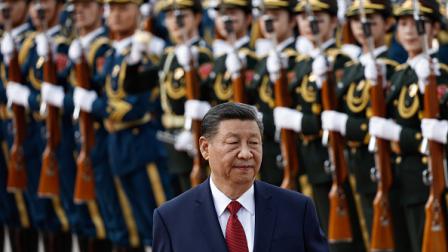هذه الاستقالة أُجبر عليها بوتفليقة تحت ضغط أكبر تظاهرات شعبية شهدها التاريخ السياسي للجزائر، ولا يزال حراكها مستمراً إلى الآن، بعدما اندلعت في 22 فبراير/ شباط 2019، مباشرةً بعد إعلان الرئيس ترشحه لولاية رئاسية خامسة، في انتخابات رئاسية كان مقرراً إجراؤها في 18 إبريل من العام ذاته. بعد عامٍ من هذه الاستقالة، تبرز أسئلةٌ ملحّة، وجولة أفق عامة عن جزائر من دون بوتفليقة. أما الأسئلة، فهي: هل انتهت البوتفليقية كملمحٍ سياسي، وهل كان العام منذ تلك الاستقالة كافياً لتجاوز مخلفات فترة حكمٍ ظهر أنها كانت مُكلفةً لمقدرات البلاد؟ ثم يأتي السؤال الأهم، وربما الأكثر إثارة، عن أسباب عدم مساءلة بوتفليقة عن سنوات حكمه، ومحاسبته عن مسؤوليته في سنوات الفساد، وخصوصاً ذلك الذي استشرى خلال السنوات السبع الأخيرة من فترة حكمه؟
أين بوتفليقة؟
"الجزائر من دون بوتفليقة أفضل"، أو هكذا يبدو المشهد بالنسبة إلى الكثير من الجزائريين، حتى وإن لم يتحقق مجموع التغيير المأمول من الحراك الشعبي. في الثاني من مارس/ آذار الماضي، تخطى بوتفليقة الـ83 من عمره، وفي الثاني من إبريل يتخطى عامه الأول خارج الحكم بعد 20 سنة من الرئاسة. هي ليست المرة الأولى التي يُجرّب فيها الرجل الإبعاد القسري من الحكم والسلطة، فقد اختبر، ولكن في ظروف صحية وسياسية مغايرة، تجربةً مماثلة في عام 1980، قضى خلالها 20 عاماً من الإبعاد.
إثر استقالته من الرئاسة، غادر بوتفليقة مقر الإقامة الرئاسية في منطقة زرالدة في الضاحية الغربية للعاصمة الجزائرية، وهو يعيش حالياً في فيلا والدته التي تقع خلف السفارة الأميركية في منطقة الأبيار وسط العاصمة. لا يتسرب الكثير عن تفاصيل حياته اليومية والمعيشية، لكن بعض ما تسرب يشير إلى أنه يحظى برعاية شقيقته زهور، وشقيقه ناصر الذي ظهر آخر مرة خلال الإدلاء بصوته في انتخابات الرئاسة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي. ويحظى الرئيس الجزائري السابق أيضاً برعاية طبية مستمرة، إذ يزوره الأطباء باستمرار لمتابعة وضعه الصحي. وتشير المعلومات كذلك إلى أن بوتفليقة لا يزال يتابع أحداث البلاد، ويبدي تأثراً كبيراً بما حلّ بشقيقه الأصغر ومستشاره السابق، السعيد بوتفليقة، الذي أدانته محكمة عسكرية بتهمة التآمر على سلطة الجيش والدولة، وحُكم عليه بالسجن 15 عاماً، حيث لم يزره في سجنه بسبب وضعه الصحي.
اختار بوتفليقة لنفسه هذه النهاية غير الموفقة سياسياً، على الرغم من تاريخ حافل، بعدما أرسى على مدار 20 عاماً تقاليد حكم انتقى لها زمرةً من رجاله، وتحولت إلى ما يشبه الخليط السياسي، الذي يجمع بين الديمقراطية والحكم الفردي والتكنوقراط، بالإضافة إلى الارتكاز على المؤسسة الدينية التقليدية (الزوايا)، وتشتيت الأحزاب وتقييد الجيش والاعتماد على الكارتل المالي. وانتهت الحقبة السياسية البوتفليقية هذه إلى الفشل، وتعويم الفساد، وإنهاك الدولة وربطها بالكارتل المالي، ما وفّر الأسباب مجتمعة لاندلاع أكبر ثورة سلمية في تاريخ البلاد، في صورة تمردٍ مفاجئ على بوتفليقة وسياساته، والسعي إلى التخلص منه، ومن زمرة الحكم المرافقة له.
مصير البوتفليقية
يعتقد الأستاذ الجامعي يحيى جعفري، وهو أيضاً فاعلٌ في "منتدى الحراك الشعبي الأصيل"، أن "الثورات السلمية دائماً، لا تذهب بعيداً في اجتثاث الجذور"، موضحاً أن "بوتفليقة رحل مع الكثير من رجاله وسياساته، وحتى مع الجو العام الذي كان يمارس فيه شهواته السياسية، ولكن لا يزال الكثير ينتظر شعبنا، والأحرار منه بالخصوص". ورأى جعفري أنّ "من الصعب الحكم على أن البوتفليقية، كأسلوب حكم، انتهت في الوقت الحالي، وبغضّ النظر عن التوجه الجديد للحكم، فإن انتهاء البوتفليقية مرتبط بمدى وصول أبناء الشعب عبر انتخابات حرة ونزيهة إلى مراكز التشريع، ومنها إلى التنفيذ، لتعطيل ما بقي من مفاعلات الإشعاع البوتفليقي السام". واعتبر الأستاذ الجامعي أن "الشارع الجزائري أدى قسطه، وأعاد التوازن إلى البناء السياسي في الدولة، لكنه يبقى أيضاً قوة ردع قابلة للاستخدام عند الحاجة". وحول الحقبة السابقة، رأى جعفري أن البوتفليقية "مرحلة تلخصت فيها كل المراحل السابقة، والقطيعة النهائية معها ستحتاج إلى بعض الوقت، لكن يجب أن نتنبه إلى أن الوضع سيكون صعباً اقتصادياً في المديين القريب والمتوسط، وذلك نتيجة عوامل عدة، أبرزها الأزمة النفطية"، داعياً إلى التغلب على الصعوبات المالية والاقتصادية، "توسيع قاعدة الحكم لمختلف الشركاء النافعين، وكذا توسيع المساحات لمصلحة الديمقراطية والحكم الراشد، إذ لا شيء أفضل من مواجهة وضع مضطرب مثل شرعية سياسية مكتملة".
لكن العديد من المتابعين يعتبرون أن استقالة بوتفليقة من الرئاسة، ونهاية مرحلة حكم كانت مثيرة للجدل في تاريخ البلاد، لا تشكلان استثناءً في مسار التغيرات السياسية التي حصلت في الجزائر، إذ لم تحدث خلخلة جذرية في النظام السياسي، باعتبار أن النظام نفسه اعتاد محطات مماثلة من تداول السلطة ونقلها، سواء بسبب وفاة رئيس، كما حدث بعد رحيل الرئيس هواري بومدين نهاية عام 1978 وتسلّم الرئيس الشاذلي بن جديد للحكم في عام 1979، أو بعد تنحي الأخير في 12 يناير/ كانون الثاني 1992، أو إثر انتخابات عام 1999 التي تسلّم عبرها بوتفليقة الحكم من سلفه ليامين زروال.
وأعرب المتحدث باسم مؤتمر المعارضة، محمد أرزقي فراد عن اعتقاده بأن "المشكلة تكمن في النظام السياسي الجزائري، لا في الأشخاص، بل في طبيعة النظام الشمولي الذي يتجاوز سيادة الشعب، ومن طبعه تغيير واجهته عند الضرورة"، لافتاً في حديث لـ"العربي الجديد" إلى أن "الكل يعلم أن مؤسسة الجيش هي التي دأبت على صناعة الرؤساء منذ استرجاع الاستقلال، ولا تزال، وبناءً عليه ليس هناك استقالة، بل إنهاء مهمة للحفاظ على طبيعة النظام الذي لا يؤمن بالدولة المدنية". وبخلاف من يعتقدون أن ذهاب بوتفليقة أتاح للجيش العودة بقوة للإمساك بالبلد وبدواليب صناعة القرار، على خلفية نجاح نسبي لبوتفليقة في إبعاد الجنرالات عن الدائرة المركزية للقرار في عهده، اعتبر أرزقي فراد أنه "لم يكن هناك خروج من السياسة، لذلك فلا يمكن الحديث عن العودة (عودة الجيش)، إذ إن كل رؤساء الجزائر خرجوا من مختبر مؤسسة الجيش"، مذكراً بأن "ما لعله يؤكد ذلك، آخر تصريح لرئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش، ذكر فيه أنه حتى في حالة ترشحه للرئاسة وفوزه بالانتخاب، لن يستطيع إحداث تغيير سياسي لعدم تغير قواعد الحكم".
غياب المحاسبة
ثمّة سؤال يُطرح بمناسبة مرور عام على استقالة بوتفليقة، وهو تعالى بشكل لافت عندما تفجرت قضايا الفساد وفضائح تورط فيها كبار رجال الحكم في عهده، من مسؤولين سامين وسياسيين وقيادات أمنية وعسكرية. ويتعلق السؤال بالأسباب الكامنة وراء عدم ملاحقة بوتفليقة قضائياً، بحكم مسؤوليته الجزائية والسياسية، والأخلاقية أيضاً، عن كل الممارسات التي جرت خلال فترة حكمه، خصوصاً المتعلقة بقضايا الفساد المرتبطة بالمؤسسات الحيوية للدولة. ومن المعروف أن عدد وزراء بوتفليقة المتورطين في قضايا فساد بلغ عددهم 30 وزيراً، بينهم 24 في السجن. وفي الأول من مارس/ آذار الماضي، انهار رئيس الحكومة الأسبق عبد المالك سلال خلال جلسة محاكمته مع رئيس الحكومة الأسبق أيضاً أحمد أويحيى، وفجّر قنبلة عندما طالب باستدعاء بوتفليقة إلى المحكمة، بصفته المسؤول عن كل ما حدث في حكوماته. وقال سلال للقاضي: "يتعين على بوتفليقة أن يحضر إلى المحكمة، هو كان رئيساً، وكان يتابع كل صغيرة وكبيرة عبر شقيقه، وهو المسؤول الأول سياسياً، لأنه هو من كان يصدّق على البرامج، بينما أنا لم يكن باستطاعتي حتى إصدار مرسوم، فلماذا لا يُحاكم الرئيس، ولو رمزياً؟".
وتشي هذه التصريحات بوضوح بأن عدم مساءلة بوتفليقة سيبقي الكثير من الحقائق طيّ الكتمان، وستغيب عن الجزائريين أسرارٌ كبيرة أحاطت بفترة مهمة من فترات الحكم في البلاد. لكن، على الرغم من وجود فعلي لمانع قانوني، يتعلق بنصٍّ دستوري يتيح فقط لمحكمة خاصة للدولة كان يفترض، وفقاً للدستور، تشكيلها من قبل بوتفليقة نفسه خلال فترة حكمه، وتختص بمحاكمة الرئيس عن أي تهم بالفساد أو الخيانة العظمى توجه إليه، وهي محكمة لم تنشأ حتى الآن، فإن الكثير من المتابعين يعتبرون أن السلطة لم تكن لديها الإرادة السياسية الكافية لمحاكمته ومساءلته، سواء لوازع أخلاقي يتعلق بوضعه الصحي (لا يقوى على الحركة والكلام)، أو لوجود اتفاق مسبق (يرجح عقده بين أحمد قايد صالح وقائد الحرس الجمهوري الفريق علي بن علي)، قضى بتقديم بوتفليقة استقالته ومنحه حصانة من أي ملاحقة.
وذهب المحلل السياسي عبد السلام عليلي، إلى الاعتقاد أن بوتفليقة "أوجد أخطر أنواع الفساد، وهو ذلك الذي تسببه شبكات المسؤولين بحكم المصالح المتبادلة وسوء استخدام السلطة العامة، من أجل مكاسب فردية، وتشمل اختلاس الأموال العامة ومصادرة أموال الشركات المملوكة للدولة من قبل موظفين رسميين أو أفراد يسيئون استغلال صلاحياتهم من أجل منافع شخصية، دون الأخذ بالاعتبار التداعيات الخطرة على البلد والشعب، وهذا كله أدّى إلى تعميق أزمة الثقة بين المواطنين والمؤسسة الرسمية، وهي مخلفات لن يجري تجاوزها في وقت قصير".
هكذا مضى عامٌ منذ استقالة بوتفليقة. خرج الرجل من نافذةٍ ضيقة لا تتسع لتاريخه السياسي في الداخل، وإسهاماته على الصعيد الدولي، وجولاته مع كبار الزعماء في القرن الماضي، وخلال السبعينيات منه خصوصاً، ودخل رواق النسيان بعدما راكمت التطورات مزيداً من الإخفاقات المعلقة عليه، لكن نهايته ستظل قصّة سياسية، وعبرةً للحكّام في الجزائر، كما في غيرها من الدول.