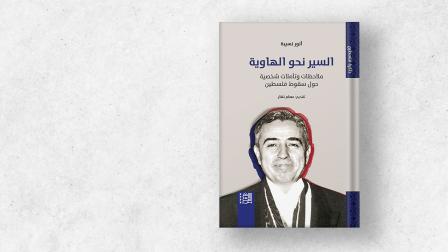كأن مهرجان وهران هذا العام سلّط الضوء بصفة عفوية على مفارقة عربية تتضح منذ سنوات، إذ يتجه النقاد للقول بوجود ما يشبه ربيعاً للأفلام القصيرة، باعتبار غزارة إنتاج هذه الأفلام وبروز أسماء أبانت عن موهبة تَعِد بالكثير.
المخرجة التونسية هند بوجمعة، الفائزة بالجائزة الذهبية عن الأفلام القصيرة في مهرجان وهران عن شريط "وتزوج روميو جولييت"، تكشف عن تصورها الخاص، فترجع وفرة إنتاج الفيلم القصير "إلى ظهور مدارس سينمائية متخصصة أفرزت جيلاً من الشباب الذي اتجه، في ظل غياب التمويل اللازم، إلى تصوير أفلام قصيرة".
تتأسف بوجمعة "لغياب المواكبة النقدية الضرورية خصوصاً في الإعلام، وعدم تخصيص مهرجانات لهذا الصنف". كما أشارت إلى "تجاهل التلفزيون للأفلام القصيرة التي توفر مادة ترفيهية تتوافق مع ذوق جمهور عريض"، داعية المسؤولين "إلى مزيد من العناية بالثقافة بمختلف أوجهها، بوصفها العدو الأول للتطرف والجهل".
إن استمرار ظاهرة الأفلام القصيرة بنفس الوتيرة -لكن باهتمام وعناية خليقين بدور السينما في حياة الإنسان- قد يشكل استئنافاً جديداً للسينما العربية، استئنافاً صحيّاً هذه المرة لأنه يحاكي تطور السينما في بدايات القرن، ويجنبها القفز على المراحل والاستعجال المرضيّ.
يعود صعود نجم هذه الفئة السينمائية إلى عوامل كثيرة ومترابطة، بداية بكونها الفضاء الذي يجد فيه المتحمسون من الشباب فرصتهم في تصوير فيلم لا يقيّد مغامراتهم "الطويلة" ويؤجلها. كثير منهم يأتي مدفوعاً بـ"بساطته" الظاهرية والخادعة وقلة منهم من يواصلون الدرب.
لكن لجوء السينمائيين الجدد للفيلم القصير، يكشف الصعوبات الجمّة التي تعترض حلم إنجازهم لفيلم طويل يحتاج فريقاً موسعاً لتقاسم مهام الإنتاج والتصوير والإخراج وإلى ميزانية معتبرة. كما أن التطوّر المطرد للتقانة السينمائية، من جهة توفر الأدوات وكذلك ظهور برامج كمبيوتر مساعدة، جعلت من يملك هذا الحلم لا يتورع بالتقدم بخطوة إنجاز فيلم قصير.
وإذا كان الفيلم القصير يعدّ في العرف السينمائي محطة ساهمت في نحت مواهب كبار الصنعة السينمائية اليوم مثل فرانسيس فورد كوبولا ومارتين سكورسيزي، فهو يعد أيضاً الطفولة الحالمة للسينما وسَلَفَها الأول، كون الأفلام تاريخياً بدأت قصيرة ثم استطالت لأسباب موضوعية وفق تطوّر صحي غير مُستعجل.
على مستوى آخر، يتميز الفيلم القصير بكونه صاحب علاقات وثيقة مع أجناس أدبية عديدة، مثل القصة القصيرة والشعر، كما لا تربطه علاقة حصرية بالدراما مثل الأفلام الطويلة التي تحكمها علاقة حتمية وحيوية مع هذا الفن القديم وتاريخه. وقد ساهمت قرابة الفيلم القصير بفنون أخرى تعرف نضجاً ملحوظاً في الأدب العربي المعاصر، في توفير مناخ إبداعي وعمق جمالي ساعد في ظهور نصوص جادّة استطاع مخرجون تجسيدها باقتدار.
هذا ويُعزى النجاح النسبي للفيلم القصير في السنين الأخيرة إلى مراكمة شهدتها الساحة الفنية العربية. مراكمة أجّجتها مواقع التواصل الاجتماعي وفضاؤها المفتوح لكل المحاولات، مما لفت الانتباه لمبدعين شباب من مناطق مختلفة، يجتهدون عبر الصورة، وعبر جماليّة نابعة من الهامش، في البحث عن شكل جديد للتعبير، متخذين -بوسائل بسيطة غالباً- هذه المنابر الجديدة كقاعات سينمائية مفتوحة على كل العالم.
هذه الحاجة الملحة للتعبير، إن جاز الوصف، تكشف عن طموح لرصد الواقع العربي الذي يتفلّت من الأيدي والعيون، مدفوعاً بزخم الأحداث المتتابعة؛ واقع يفرض نفسه على هؤلاء في صورة معاناة ومعيش يوميّ مفعم بالتناقض، ويشكل مناسبة دائمة لهم لاقتحامه فنيّاً من أجل رفضه تارة، وملابسته والقبض عليه تارة أخرى.